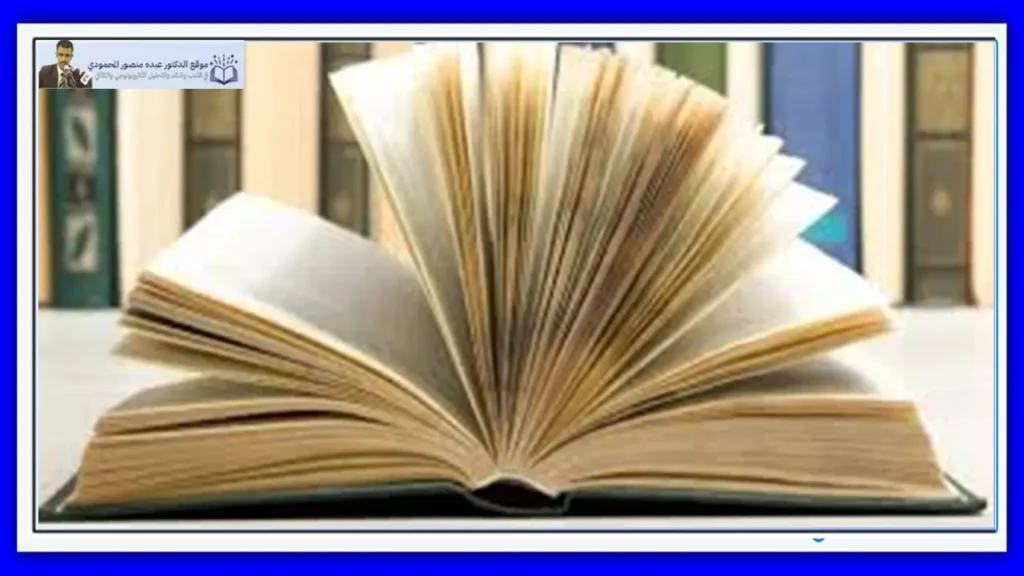العربية الفصحى ودراساتها الوصفية
يمكن الوقوف على نماذج من الدراسات اللغوية الوصفية، لظواهر لغوية في العربية الفصحى، في استعراض بعضٍ من إسهامات الأستاذ الدكتور عباس السوسوة في هذا السياق من منهجية البحث اللغوية. لا سيما في ما اشتغل عليه، من ظواهر نحوية وصرفية.
[1]: النحو العربي والدراسة الوصفية
لقد كان لظواهر الفصحى العربية المعاصرة النحوية النصيب الأوفر في دراسات الدكتور عباس السوسوة النحوية الوصفية. إذ جمع في القسم الثالث من كتابه “العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية”، بين إجراءات المنهجين: التاريخي، والوصفي. ومن تلك الظواهر: ظاهرة الإعراب، وظاهرة مصاحبة حرف الجر للفعل المبني للمجهول.
[1ــ1]: الإعراب
يصف السوسوة الصورة التي تأتي بها علامات الإعراب مستخدمة في العربية الفصحى المعاصرة، إذ تتخلى عن الحركات الإعرابية، وتميل إلى التسكين. فيقول: “في الفصحى المعاصرة بعض الاتجاهات الشائعة للتخلي عن علامات الإعراب، في بعض المواقع والتراكيب، لا تعد خطأً، بل أصبحت صوابًا، إذ لا يستنكرها أحد من مستخدمي هذا المستوى”(1).
وقسم هذا التخلي على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: “يتمثل في أسماء الشهور السريانية، مثل: كانون ثاني، وتشرين أول (… إلخ)، فيجوز الوقوف عليها بالسكون أو إلحاق علامة المنع من الصرف بها”(2).
والقسم الثاني: يتمثل في التخلي عن علامات الإعراب، والميل إلى التسكين مع الأعلام المتتابعة. مثل: (سافر محمد علي حسن)، أو الرتب والألقاب التي تسبق هذه الأعلام المتتابعة، حيث “يُلاحظ ــ في الإعلام المسموع والمرئي ــ أن السكون تعدى هذه الأسماء المتوالية إلى الألقاب والرتب التي تسبقها، مثل: الرئيس محمد حسني مبارك…”(3).
وذكر أن “مجمع اللغة” القاهري، قد أجاز تسكين الأعلام المتتابعة، حين قرر أنه “يجوز الوقوف بالسكون عند تتابع الأعلام في مثل: (سافر محمد على حسن) مع حذف (ابن) تيسيرًا على القراء والكتاب، وتخلصًا من صعوبة الإعراب”(4).
كذلك، يصف في هذا القسم، التخلي عن علامات الإعراب الأصلية في الأسماء الخمسة، فهي في العربية المعاصرة تلتزم “سمتًا واحدًا، أي تظل مبنية كما هي عليه، ففيها مثل: أغاني الفنان أبو بكر سالم، ورئاسة الدكتور أبو الحسن بني صدر…”(5).
كذلك، يقول: “إن الأسماء المركبة من (اسم علم + اسم علم) مثل مباحثات الحسين مبارك، أو الأسماء المركبة من (اسم علم مكان + علم ــ أو أكثر ــ يدل على مكان) مثل: محور خلدة المتحف المطار، كلها مبني على السكون”(6).
ويشير إلى هذا التسكين، في بحثه “لغة التدريس في جامعة تعز دراسة حالة”، في مستواها الفصيح، إذ إن “هذا المستوى فيه التزام بعلامات الإعراب الأصلية والفرعية، ووقوفٌ على نهاية الجملة وعلى طرفي التركيب بالسكون”(7). كذلك هو الأمر في مستواها عامية المثقفين، ففي هذا المستوى: “اللجوء إلى التسكين، وعدم تعقيد العلاقات النحوية بين أطراف التركيب”(8).
وهو هنا وصف الظاهرة، لكنه لم يعللها. والتعليل واحدٌ من إجراءات المنهج الوصفي. ثم إن هناك من علل هذه الظاهرة؛ إذ يرى البدراوي زهران “إن الغناء في كثير من حالاته من العوامل المساعدة على المخالفات الإعرابية لنحو الفصحى ومن أمثلة ذلك تلك الأغنية التي كان يوقف على آخر كلماتها بالسكون:
قاضي القضاة عزل نفسه ** لما ظهر للناس نحسه“(9).
ويضيف البدراوي زهران معلقًا على هذا البيت: “وسواءٌ علينا أوحى قالبها أو مضمونها بأنها زجل أو شعر فإن موسيقا نطقها تفرض مخالفات إعرابية أخرى حيث تتطلب اتحاد حركة السين في (نفسه) و(نحسه) بينما حركتهما ليست واحدة، ودلالة ذلك أن الغناء من العوامل المعينة على المخالفات الإعرابية”(10).
أما القسم الثالث، فيتمثل في: “أن الظرف (حيثُ) يأتي في الفصحى وبعده جملة فعلية في الغالب. أما إذا ورد اسمٌ بعده فإنه يكون مرفوعًا. وقد ورد الظرف (حيث) على ندرةٍ مضافًا وبعد اسم مجرور بإضافته إليه …
وهذه القاعدة النادرة أصبحت [في] الفصحى قاعدة أصلية مثلها في ذلك مَثَلُ القاعدة الفصحى”(11).
[1ــ2]: مصاحبة حرف الجر للفعل المبني للمجهول
يتحدث السوسوة، في الفصل الرابع، من القسم الثالث، في كتابه “العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية”، عن المصاحبة في العربية الفصحى المعاصرة. ومن هذه المصاحبة “مصاحبة حرف الجر للفعل المبني للمجهول”، التي تمثل نظامًا ثالثًا، يضاف إلى نظامي الفعل في العربية: المبني للمعلوم، والمبني للمجهول. ويتمثل هذا النظام الثالث في “مصاحبة حرف الجر للفعل المبني للمعلوم مع ذكر الفاعل الحقيقي”(12).
ويذهب مفسرًا ومفصلًا هذه المصاحبة، ومحللًا لجزئياتها؛ إذ تقوم على(13):
1ـ تغيير صيغة الفعل من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول.
2ـ يُذكر نائب الفاعل في الجملة (بعد أن كان اسمًا منصوبًا على المفعولية في الجملة التي تصرح بذكر الفاعل).
3ـ يصاحب نائب الفاعل شبه جملة مكونة من جار ومجرور، لا تكاد مكوناتها تخرج عن: من قِبَل، من طرف، بواسطة.
4ـ يلي شبه الجملة الفاعل الحقيقي للفعل، في حالة جرٍّ بالإضافة إليها.
ثم يورد عددًا من الشواهد لهذا النظام ــ الظاهرة ــ المعاصر. منها:
“أُلقيت في الحفل كلماتٌ من قِبَل الفائزين بجائزة الملك فيصل”(14). و”هذه ظاهرة يمكن للجهات المختصة دراستها”(15).
ولأن من أبرز الأسس التي يقوم عليها المنهج الوصفي خاصة، التعليل مسبوقًا بالتحليل والتفسير؛ فإنه ــ السوسوة ــ قد علل لهذه الظاهرة النحوية في العربية الفصحى المعاصرة، فهي متأتيةٌ بفعل “احتكاك المثقفين العرب في العصر الحديث باللغات الأوروبية قراءةً وترجمة”(16)؛ ذلك لأن “الفعل ــ المشابه للمبني للمجهول في العربية ــ في الإنكليزية والفرنسية يأتي بعده إما (by) في الإنجليزية أو (par) في الفرنسية، ثم يلي هاتين الأداتين الفاعل الحقيقي للفعل”(17).
[2]: الصرف العربي والدراسة اللغوية الوصفية
درس الدكتور عباس السوسوة عددًا من الظواهر اللغوية الصرفية، في اللغة العربية الفصحى، حيث احتوى القسم الثاني، من كتابه “العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية”، دراسة وصفية لعددٍ من الظواهر الصرفية، بمحاذاة دراسته التاريخية لهذه الظواهر. كذلك، في غير هذا الكتاب، تضمّنت مواضع من أبحاثه اللغوية دراسة وصفية، لظواهر صرفية فصحى، في إطار المنهج التاريخي أو بدونه. ومن تلك الظواهر: جمع التكسير، وجمع المصدر، والنسب، والاشتقاق من الأجنبي.
[2ــ1]: جمع التكسير
ترتكز دراسته لهذه الظاهرة في العربية الفصحى المعاصرة، على إبراز حال الاستعمال لهذا النوع من الجموع بقسميه: جموع القلة، وجموع الكثرة. فبعد أن يبين هذا الجمع، واتفاق الصرفيين على تقسيمه إلى قسمين: جموع قلة وجموع كثرة، يصف استعماله في العربية الفصحى المعاصرة والقديمة. ففي العربية القديمة، قام استعمال هذا الجمع على التمييز بين قسميه: جموع القلة، وجموع الكثرة ” والتمييز بين جمع القلة وجمع الكثرة في إطار جمع التكسير من سمات الفصحى قبل العصر الحديث”(18).
ويصف استعمال العربية المعاصرة لجمع التكسير، بعدم التمييز بين قسميه، مُدَعِّمًا وصفه هذا، برؤية السعيد محمد بدوي في ذلك: “والحق الذي لا مرية فيه أن التمييز بين جموع القلة والكثرة لم يعد قاعدة أصلية في العربية المعاصرة، لذلك نرى السعيد محمد بدوي محقًا عندما عدَّ وجود جمعي القلة والكثرة من المميزات التي تميز فصحى التراث، إذ لم يعد لصيغ جمع القلة مغزى في الاستعمال الحديث للفصحى”(19). أي أن الدلالة واحدة للجمعين، من دون تمييز لأحدهما عن الآخر. لكنه ــ السوسوة ــ استدرك أمرًا آخر، هو ما أسماه بـ (التفضيل)، تفضيل الكُتاب استخدام صيغ في موضعٍ معين، واستخدام صيغٍ أخرى في مواضع أخرى؛ إذ يقول:
“ورغم استواء صيغ الجمع الباقية في العربية المعاصرة، في دلالتها على الجمع، إلا أن الكُتّاب ــ دون استثناء ــ يفضلون استعمال بعضها في موضوعٍ دون آخر. فمن ذلك استعمال (البحار) في كل الموضوعات السياسية والاقتصادية والعسكرية والجغرافية والتاريخية، إلا في الكتابة عن الشعر، فإنها تُستبعد وتحل محلها واحدة من الكلمتين: بحورًا وأبحر”(20).
فهو هنا وصف الاستعمال القديم والمعاصر لهذا الجمع، مبينًا الفرق في الأساس الذي يقوم عليه هذان الاستعمالان. ووصفه هذا منتظمٌ في نسق البحث التاريخي، الذي قام عليه كتابه “العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية”.
[2ــ2]: جمع المصدر
هذه الظاهرة، موضوع من موضوعات الفصل الخامس، من القسم الثاني في كتاب السوسوة “العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية”. وفيه يصف “ظاهرة جمع المصدر”، ويبين أن لها وجودًا في العربية الفصحى القديمة والمعاصرة. مع الأخذ بعين الاعتبار وجودها فيما بين هاتين الفترتين الزمنيتين.
ويصف وجود هذه الظاهرة في عربية عصر الاحتجاج(21)، ويؤكد ذلك بقول (سيبويه) في هذا الأمر. إذ يورد نصه: “وهم قد يجمعون المصادر فيقولون: أمراض وأشغال، وعقول، فإذا صار اسمًا فهو أجدر أن يجمع بتكسير”(22). ويورد ــ أيضًا ــ قول السيرافي شارح “كتاب” سيبويه في هذا الجمع: “قد تجمع المصادر إذا كانت مختلفة أو ذُهبَ مذهب الخلاف…”(23).
ويصف وجود الظاهرة في العربية الفصحى المعاصرة، فيقول: “وجمع المصدر بالألف والتاء شائعٌ في الفصحى المعاصرة”(24). ويفصل القول في ذلك، فمن هذه المصادر المجموعة ما يقوم على فعلِ ثلاثي ماضِ مثل: طموحات، ولقاءات. ومنها ما يقوم على أفعال: رباعية، أو خماسية، أو سداسية؛ حيث ينحصر هذا الجمع في هذه الأفعال، في ثمانية أوزان أوردها مع التمثيل لها. هي: فَعَّل، أفعَل، فاعَلَ، افتَعَلَ، انفَعَلَ، تفَعَّلَ، تفَاعَلَ، استفعَلَ(25).
[2ــ3]: النسب من الأجنبي
يصف الدكتور عباس السوسوة ظاهرة النسب من الأجنبي في العربية الفصحى المعاصرة، فيقول: “في العربية المعاصرة طائفة من الألفاظ الأجنبية المنقولة بلفظها إما من الإنكليزية أو الفرنسية”(26).
ثم يبين كيفية النسبة إلى هذه الألفاظ، مع احتفاظها بالكيفية التي بها يُنسب إليها في لغتها الأصلية، فيقول: “وهذه الألفاظ عُربت، وهي منسوبة أصلًا بلاحقة من لواحق النسب في هاتين اللغتين وأضيف إليها الياء المشددة المكسور ما قبلها من العربية، فأصبحت تحمل علامتين”(27).
ويتبع ذلك، بجدولٍ ذي ثلاثة حقول: الأول للفظ الأوروبي، والثاني لنسبة هذا اللفظ في لغته، والثالث لصورة هذا اللفظ في العربية. ويضيف إلى جدول أمثلته، مثالين شائعين في النقد والأدب، هما: (كلاسيكي) و(رومنتيكي)، فيقول عن النسبة فيهما: “فالكاف (ic) مع الكسرة قبلها هي لاحقة النسب في اللفظين، وزادت العربية المعاصرة ياء النسب”(28).
كما يشير إلى وجود مثل هذه الظاهرة في تراث العربية، بقوله: “وقد كان شيء من ذلك في التراث العربي، عند نقل ألفاظ يونانية، عربت فيها علامة النسب (ic) أو (ica) بالقاف، وأضيف للفظ المعرب ياء النسب العربية”(29).
[2ــ4]: الاشتقاق من الأجنبي
حينما يتحدث السوسوة عن لغة التدريس في “قسم الكيمياء”، في بحثه الموسوم بـ “لغة التدريس في جامعة تعز، دراسة حالة”، يصف هذه الظاهرة، قائلًا: “وللعربية في الاشتقاق دور في الصياغة من الأجنبي، مثل: هدرج يهدرج وهدرجة (من هيدروجين)”(30). ويذكر أن هناك ألفاظًا أجنبية، تأتي بصورةٍ مهجنة، موضحًا ومفصلًا الكيفية التي تظهر فيها هذه الألفاظ: “وبعض الأجنبي يظهر في صورةٍ مهجنة مثل: كبريتيك وكبريتيد وكبريتور، التي رأسها الأول عربي. أما جزؤها الثاني فالزيادات فيها ليست مجانية، إنما هي دليل تغير الذرات أو الجزئيات في التفاعل…”(31).
- عباس علي السوسوة، “العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية”: دار غريب، القاهرة، 2002م، ص: (125). ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه، ص: (126). ↩︎
- نفسه. وانظر: مجمع اللغة العربية، “مجلة مجمع اللغة العربية”. القاهرة، 1966م، جـ20/ ص: (111). ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه، ص: (127). ↩︎
- عباس علي السوسوة، “لغة التدريس في جامعة تعز، دراسة حالة”. كتاب مؤتمر: (التعليم باللغات الأجنبية في العالم العربي). كلية دار العلوم، جامعة القاهرة. في الفترة: (12 ــ 13) فبراير 2006م، ص: (89). ↩︎
- نفسه. ↩︎
- البدراوي زهران، “في علم اللغة التاريخي، دراسة تطبيقية على عربية العصور الوسطى”. ط4، دار المعارف، القاهرة، د.ت، ص: (382). ↩︎
- نفسه. ↩︎
- عباس السوسوة، “العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية”. مرجع سابق، ص: (127). ↩︎
- نفسه، ص: (157). ↩︎
- نفسه، ص: (158). ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه، ص: (189). ↩︎
- نفسه، ص: (158). ↩︎
- نفسه. وانظر: محمد أبو عبده، “مشاكل التعريب اللغوية”. مجلة اللسان العربي، الرباط، 1982م، جـ1، المجلد (19)، ص: (107). ↩︎
- نفسه، ص: (60). ↩︎
- نفسه، ص: (61). وانظر: السعيد محمد بدوي، “مستويات العربية المعاصرة في مصر”. دار المعارف، القاهرة، 1973م، ص: (140). ↩︎
- نفسه، ص: (63). ↩︎
- نفسه، ص: (67). ↩︎
- نفسه. وانظر: سيبويه، “الكتاب”. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط2، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1973 ــ 1979م. جـ3/ ص: (401). ↩︎
- نفسه. وانظر: أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي، “شرح كتاب سيبويه”. تحقيق: محمود فهمي حجازي، ورمضان عبد التواب، ومحمد هاشم عبد الدايم. الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1986م، جـ1/ ص: (64). ↩︎
- نفسه، ص: (68). ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه، ص: (95). ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه، ص: (96،95). ↩︎
- عباس علي السوسوة، “لغة التدريس في جامعة تعز، دراسة حالة”. مرجع سابق، ص: (88). ↩︎
- نفسه. ↩︎