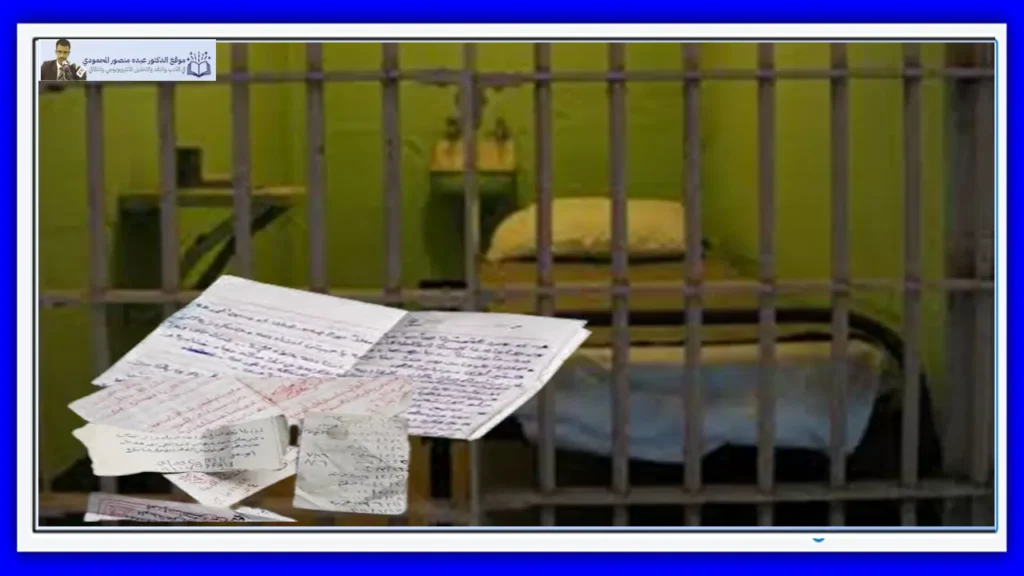الحب في حكايا من اليمن سرديات العاطفة والألم(1).
تعاطت الكاتبة اليمنية ريم مُجاهِد، في كتَابِها “حَكَايا مِن اليَمَن”(2)، مع سياقات وتفاصِيل مُتعَدّدة. في صياغاتٍ سردية مُتَدَفِّقة، أفضت إلى استواء نصوص الكِتاب رِوايَةً، ازدحَمت بأحداثها اليمنية البحتة، ومضامينها الحياتية المتشابكة. التي تجسّدت فيها عاطفة الحب في حكايا من اليمن.
بُنية الشخصية
من خلال الأحداث الكاثرة، المتقاطعة بمنطقيةٍ زمنيةٍ وموضوعيةٍ فاعلة، تشكلت سردية الحب في حكايا من اليمن. من خلال سياقات سردية، توزّعت تفاصيلها على الشخصيات الأربع الرئيسة: “عَلي”، و”ماجِدة”، و”سلْمى”، و”نادِية”. ومثلها عددٌ من الشخصيات الثانوية، التي تماهت مع أحداثِ العمل. كما تماهت مع تفاصيله، التي اشتبكت فيها غايات الشخصيات الرئيسة فيه.
تميّزتْ شخصيةُ “علي”، بعدد من الخصائص. التي أهَّلتْها إلى أن تكون شخصيةً محورية، اتّصلتْ بها الأحداثُ والأفكارُ ومصائرُ الشخصياتِ الرئيسة، بتفاوتٍ نسبيٍّ من شخصيةٍ إلى أخرى. وقد كان الحب أيقونةَ اتصالِ هذه الشخصية الفاعل في حياة ومصير الشخصيتين: “ماجدة/ وسلمى”. كما كانَت صِلةُ القرابِةِ هي عامل اتّصال “علي”، بِحيَاة “نادِية”، بِشَكْلٍ لم يكُنْ فاعِلًا في صياغةٍ جوهريّةٍ لمصيْرِها.
شخصيةُ “علي” مهتزة، ساذجة. فهو يبحثُ عن الحُبّ؛ إذ استهلّ البحث عن غايته ــ هذه ــ في سنته الجامعية الثانية. حينما تحدث مع زملائه عن إعجابه بفتاةٍ ثرية، فكان أضحوكةً بينهم. وقد وصل به هذا البحث إلى مصير العنوسة. بعدما أصاب اليأس أمّه، من اسْتِمالتِه نحْو فتاةٍ من تلك الفتيات. اللّوَاتي كثيرًا ما سردتْ أسْماءهنّ علَى مسامعِه، في كثيرٍ من المناسبات.
حبٌّ من طرفٍ واحد
تَدْخل “ماجدة” حياة “علي” وجدانيًّا، بشخصيتها القروية المتطلعة إلى الحب. المُطَّلِعة على كثيرٍ من مظاهر التعاشق، وأخبار العلاقات الغرامية، من خلال ما تتبادله الفتيات من حديث حول ذلك. لم تحسم أمر عاطفتها مبكرًا كغيرها من الفتيات. ثم بدأت بالتفكير بجدية في الموضوع منذ شاهدت ذاك الجامعي عائدًا من المدينة.
كانْت هِي مَن بادَرَت في لَفت انتْباه حبيْبها الجَامعيّ القَرَويّ “عَلي”. إذ تفرّدت مِن بين الفَتياتِ، فيما أقدمت عليه من التقاطها لِعلبةِ الشّكولاتة من يده، وهو يمد بها إليهن. حينما صادفهن في طريقه عائدًا إلى قريته، في إحدى سفرياته بين مدينة دراسته وبين قريته.
اتجهت إليه، وبقصديةٍ ثبتتْ عينيها في عينيه؛ لتربكه. أربكتْ “ماجدة” اتزان “علي”، وتوغل فيها تداعي الموقف، غير مُلامِسٍ عاطفةَ الحَبيب، الّذي كان تعاطيهِ معْها تعاطيًا مشوبًا بعَاطِفةٍ انتهازِيّة، استوْعَبتْ سلسلةُ مَشاهِدها علامات الحبّ الذي يُكنُّهُ لـ “ماجدة”، من مثل تداعيه معها مُبادِلًا إيّاها الابْتِسامات، والسَّلام العَابِر.
حرصت “ماجدة” على اسْتِثمار كُل موقفٍ تجد فيه ما يُقرّبُها منْه. ثم تشجّعت، فاعْترضت طريْقه، غير مباليةٍ بِما انتهت إليهِ محاوَلاتُها، مِن نسْج الوَشايات حولها بصورة مبالغةٍ في توصيف علاقتها به. وبذلك، أثارت هذه الوشايات حفيظَة أهلها، فقرروا تزويجها من ابن خالتها. استعانت بابنة أخت حبيبِها في إبلاغه بالأمَر، لكنّه خيّب ظنّها، إذ جَبُن، ونَفى أن تكون له أية علاقة معها. ثم اضطلعت أمُّه وأخْتُه بصياغةِ الرّد القاسي، نيابةً عنْه. حينها، لم تجد العاشقة ـــ بعد أن وصلها ذاك الردّ ـــ إلا التخلص من حياتها.
نفذت قرارها، وأنهت حياتها في خزان الماء الكبير. خالجتْها في آخر لحظةٍ فاصلةٍ بين حياتها وبين مغادرتها أمنيةُ الشقاء للحبيب، وهو ما لازم حياة “علي” بعدها. كانت الضوضاء متخمةً بالحيرة، في كيفية إخراج جسد الفتاة من خزان الماء. وجد “علي” في نفسه ما يدفعه إلى المبادرة في الاضطلاع بالأمر، أخرج جسدها. ثمّ بادر ثانيةً في تولي حفر قبرها، محاولة غير مجدية منه في مواراة مشاعر الندم، التي سحقتْه تلك اللحظة.
الحب في سياق تواصل اجتماعي
استجدّ في حياة “علي” مسارٌ وجداني آخر، حينما تخلَّقتْ قصةُ الحب بينه و”سلمى”، في مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وطأة انعدام المسارات الحياتية الأخرى لشغل الفراغ.
تنامت علاقتهما باتساقٍ مع ماهيتها العاطفية، وتفوّقت هي عليه في السحر العاطفي وفي مهارة الكتابة. “سلمى” كانت معذبةً بانتمائها إلى طبقة اجتماعية أقل شأنًا من طبقة “علي”، لانتمائها إلى قاعدة الهرم الاجتماعي، لم تطلعْه على هذا السّر، فلم تخسرْ هالَتَها في تقديره. وحينما التقى الحبيبان صعقتْهما المفاجأة، فانصدم بحقيقتها الاجتماعية، وانكسرتْ وهي تُلاحظ عَليهِ ملَامَحَ انسِحابه وتَخَلّيْهِ عنْها. وفي تلك اللّحظة الحَرجة نفسها افترقا، إذ داهم أشخاصٌ المكان، وقبضوا على من فيه بحجة الاختلاط. كان الحبيب واحدًا من المقبوض عليهم، أما الحبيبة فقد نجت؛ بفضل لونها؛ إذ حال هذا اللون دون أن يشك المداهمون في هوية صاحبته، التي ظنّوا أنها ليست سوى عاملة من العاملات في ذاك المكان.
بعد ذلك، قطع “علي” تواصله مع “سلمى”، تمزق بازدواجية رؤيته فيما حدث، ازدواجية بين غضبه منها وغضبه عليها. كان حبّها مهيمنًا على مشاعره ولا مجال للفكاك منه، تخطفه طريقان، الأول أن ينتصر فيه لحبهما، والثاني لتعاليه الاجتماعي، فكان الثاني منهما هو المنتصر، واستمرأ “علي” إحساسه بأنه ضحية لخداع الحبيبة.
لم تبرأ هي من حبه، وظلّت مسكونةً بانصعاقها من سلبية موقفه. فوجئت بخبر اختفائه، بحثت عنه، غير شاكةٍ في استحالة عودته إليها، فهو من تخلى عنها، ولن يقبل بها. لكنها مع ذلك، ذهبت تعزِّي نفسها، بأنها فقط ستخرجه من سجنه، ثم تبصق في وجهه منتصرة لكرامتها. صعقتْها المفاجأة التي لم تكن تتوقعها؛ إذ وجدتْه وهو يخرجُ من مكان اعتقاله، وكأنه نوعٌ من “المومياء”، التي تقترب من الفناء. نظرت في عينيه، لكنه كان فاقدًا القدرة على التفوه بكلمة واحدة. لقد كان الشقاء جرحًا داميًا في ذاته، كان تحقيقًا لأمنيةٍ قديمةٍ لاذت بها حبيبته “ماجِدة” وهي تلفظ آخر نفس من حياتِها.
تداعياتٌ وعاطفة افتراضية
في المصير العاطفي ــ الذي آلت إليه حياة “علي” ــ تظهر تداعياتُ قصة “ماجدة” بحيويةٍ. ومثل ذلك، هي حيوية تداعيات تلك القصة، في حياة قريبتها “نادية”، وإن بصورةٍ أخف منها في حياة “علي”؛ كون تلك التداعيات ليست سوى قدرٍ احتماليٍّ، في مصير “نادية”. تلك الفتاة اللامبالية بشيء، غير الملتزمة بشيء، الباحثة عن الحرية، الكاسرة القيود التي تطوقها بها أسرتها، مثلها كمثل غيرها، من فتيات مجتمعٍ مكبوتٍ منفصم. تجمعها صلة القرابة بكليهما (“علي”/ “ماجدة”).
لم تشعر “نادية” بميلٍ عاطفيٍّ نحو “علي”، على أنها مثله، من المحلقين في فضاء (الفايس بوك) بحثًا عن الحب. في تماهٍ “تتشاركه مع الآلاف من الشبان والشابات في مجتمعها والمجتمعات المشابهة: يبحثون عن الحب. ولم يكن من المخيف أو الغريب أن يكون هذا الحب افتراضيًّا وله مخاطره, كانت الغاية هي الشعور ذاته والقصة فحسب، وما يليه أو ما سيؤول إليه متروك للأقدار تقرره أو تعبث به”.
الحبكة السردية
تأَطَّرَتْ سرديةُ عاطفة الحب في حكايا من اليمن، في واحدٍ من أشكال البناء الروائي. ذاك الشكل، الذي يبدأ سرديةَ الأحداث من النهاية، إذ بدأ عمل الكاتبة ـــ هذا ـــ من حدث النهاية (وفاة ماجدة وتداعياته)، فكانت بدايته هي أحداث تلك اللحظة، التي تم فيها إخراج جسد الفتاة من خزان الماء. بعد ذلك، تتابعت سرديةُ الحكاية، في تصاعدٍ منسوجٍ بمنطقيةِ الأحداث المتتابعةِ، وصيرورة الزمن المستمر، غير المتضمن استباقاتٍ أو استرجاعاتٍ جوهرية. وبلغَ هذا البناء السردي المُتصاعد ذروته، في صياغته لنهاية العمل، التي تجانسَ تَأْطيْرُها مع البِداية، من خلال استقامة تأطير النهاية، على نسقٍ من التنوير لمسارات الحِكاية بحيْثيّات الوفاة، التي تجلّت في سردية قصة الحب، بطرفيها (“ماجدة”/ “علي”)، ونهايتها المأساوية.
قصة “ماجدة” تلك، لم تكن تأطيرًا للبداية والنهاية فحسب. وإنما كان لها حضورها الحيوي في العمل. فقد ظهرت هذه القصة في أكثر من موضعٍ فيه، فجسّدت فكرةً سرديةً نُسِجتْ بها النصوص؛ إذ تكاثف حضورها في البداية. ثم بشكل متقطع في مواضع من العمل، لتظهر كثافتها بشكل أكبر وحقيقتها بجلاء، في النص الأخير، المعنون بـ “فستان مزركش يطفو”.
إضاءة
ريم مجاهد، كاتبة يمينة، تنشر كتاباتها في أكثر من منصة ومجلة محلية وعربية، منها منصة السفير العربي، ومجلة العربي الجديد.
- عبده منصور المحمودي، السفير العربي العدد: (456) 8 تموز ــ 14 تموز 2021. ↩︎
- ريم مجاهد، “حكايا من اليمن”، سلسلة كتب السفير العربي، الإصدار الثاني، بيروت، 20يونيو 2021م. ↩︎