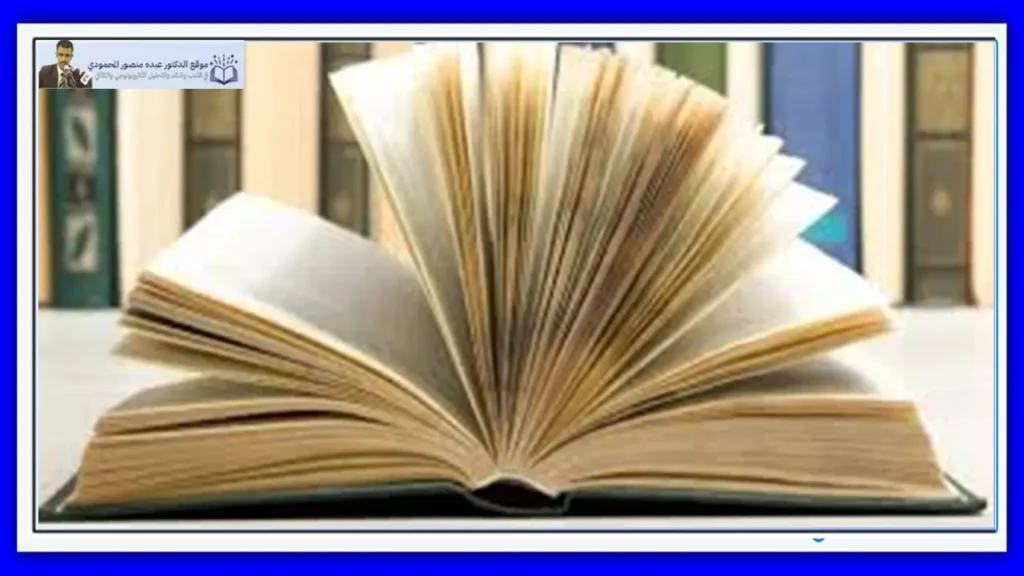مجالات الدراسات اللغوية
من زاويةٍ تفصيلية، تتفرع الدراسات اللغوية إلى فروعٍ متسقة مع المكونات المحورية في أية لغة من اللغات. تلك المكونات، التي تتوزع على مجالات أربعة: النحو، الصرف، الدلالة والمعجم، الأصوات. إذ يمكن دراسة أيّ مجال من هذه المجلات، بمناهج علم اللغة الحديث الأربعة: التاريخي، والوصفي، والمقارن، والتقابلي.
[1]: مجال الدراسات اللغوية النحوية
من أهم خصائص البُنى التركيبية (النحو) في أيّ لغة من اللغات الإنسانية، أنها بُنى حيّة. لذلك؛ تختلف منهجية دراستها باختلاف موضوع الدراسة، ونوعية الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه. لا سيما ما يتعلق من هذه المنهجية، بآليات المنهجين: التاريخي، والوصفي.
[1ــ1ــ1]: الدراسات النحوية التاريخية
يدرس المنهج التاريخي ــ في مجال النحو ــ الظاهرة النحوية في أكثر من نقطةٍ زمنية. بهدف معرفة الفرق الحادث في البنية النحوية(1). وهذا ما ينبغي التنبه له في دراسة النحو العربي. إذ يؤكد الدكتور عباس السوسوة، أن بعض ظواهر النحو العربي قد مرت بمراحل تطور مختلفة، مثلها مثل الظواهر الدلالية. مع فارق الزمن بين كلٍّ منهما. ذلك؛ لأن “التغير النحوي يحدث ببطء مع مرور الزمن، وهو غير محسوس كالتغير الدلالي”(2). بمعنى أن هذا التغيير “ليس سريعًا كما هو الحال في تغير دلالات الألفاظ. بل لا يكاد يحس، وعلى المؤرخ هنا أن يرصد ما تأتي به المعطيات، فيتتبع الظاهرة ــ أو الظواهر ــ سواءٌ حدث تغير أم لم يحدث”(3).
[1ــ1ــ2]: دراسة النحو العربي
دراسة البنى التركيبية في اللغة العربية دراسة تاريخية، لا يزال ــ كغيره من جوانب الدراسة التاريخية ــ بحاجة إلى مزيد من الجهود. فمنذ القرنين الثاني والثالث الهجريين حتى القرن العشرين، لم يحظَ هذا الجانب بالدراسات العلمية الجادة.
لقد “قام علماء القرنين الثاني والثالث بدراسة الفصحى دراسة أقرب ما تكون إلى الدراسة الوصفية الحديثة التي تحدد زمنًا ومكانًا ومستوى للمادة المدروسة… أما العلماء الخالفون فلم يتجاوزوا الحد الزمني الذي سمي عصر الاحتجاج”(4). إذ “لا فرق في ذلك بين نحوي من القرن الخامس أو الثامن أو الثالث عشر للهجرة”(5).
ولم يختلف الأمر في القرن العشرين؛ إذ “ظل الدرس النحوي ــ في معظمه ــ يسير على نهج الأقدمين. وحتى الذين نقدوه، أو طعموه ببعض إجراءات مناهج الدرس اللساني الحديث على تعدد هذه المناهج، كانوا مزورّين عن الدراسة التاريخية، ربما لصعوبتها”(6). ذلك؛ لأن دراسة النحو العربي تاريخيًّا، “أمرٌ مازال الباحثون العرب مبتعدين عنه؛ لصعوبته. فهو يقتضي منهم تتبع هذا التغير في كل تراثنا المكتوب على حقبٍ تاريخية”(7). أو “لتوهم كثيرين أن نحو العربية هو هو لم يتغير، أو لتوحيد بعضهم بين علامات الإعراب والفصحى…”(8).
لذلك؛ فإن البحوث التي تتناول هذا الجانب في الدراسات اللغوية العربية، لا تتسم بالجدية والعلمية اللازمة. و”من اللافت أن مبحث تأريخ النحو على وجه الخصوص تحول في الدراسات العربية إلى ما يشبه التسلية وتزجية الوقت بالظُّرف والحكايات الطريفة، فمباحثه في أكثر الكتب التي تعرضه تكاد تكون استراحة من عناء الجد في قراءة المسائل والقضايا الجافة الأخرى”(9).
[1ــ2]: الدراسات النحوية الوصفية
يقال إن أول محاولةٍ لدراسة النحو دراسة لغوية وصفية كانت عند “رأس القواعديين (بانيني) Panini في التراث الهندي في القرن الرابع قبل الميلاد؛ إذ قسم المفردات إلى أربعة أقسام: (الأسماء، والأفعال، وحروف الجر، والأدوات)”(10).
كذلك، كانت إسهامات (أفلاطون) و(أرسطو) والنحاة اليونان من هذا الاتجاه. وقد تمثلت في تصنيف الجملة؛ فهي إما مكون اسمي Nominal، وإما مكون فعلي Verbal، والمكون الثالث الذي أضافه (أرسطو)، وهو الروابط (الحروف) Syndesmo، إضافة إلى الأداة والضمائر(11).
وقد كان للعرب باعهم في البدايات الأولى لهذا النوع من الدرس اللغوي. إذ “جاءت الدراسات النحوية والتركيبية عند العرب بعد مرحلة جملة المفردات وتدوينها فأعملوا الفكر، واستقرأوا اللغة واستنبطوا القواعد والكليات العامة متأثرين بالفقه وعلم الكلام فظهر قرآن العربية (كتاب سيبويه)، الذي انتهج المنهج الوصفي”(12).
وازدهرت الدراسات النحوية الوصفية في العصر الحديث. في إطار ازدهار المنهج الوصفي وإقبال الدارسين عليه؛ فصارت “دراسة أي جانب من جوانب بناء الجملة في مستوى لغوي واحد تعد دراسة نحوية بالمنهج الوصفي”(13).
[2]: مجال الدراسات اللغوية الصرفية
لا شك في أن بُنية أية لغة من اللغات الإنسانية قائمة على عددٍ من الخصائص التكوينية. تلك الخصائص، التي يمكن الوقوف عليها، من خلال آليات مناهج علم اللغة الحديث، كأن نتخذ في دراسة عددٍ من الظواهر الصرفية في لغة ما، آليات منهجية: تاريخية، أو وصفية، أو مقارنة.
[2ــ1]: الدراسات الصرفية التاريخية
الصرف بمعناه العام، علمٌ يبحث أبنية الكلمة مفردة قبل أن تدخل في تركيب الكلام. والدراسة اللغوية التاريخية لهذا المجال، تتناول التغييرات التي تطرأ على أبنية الكلمة، وترصد هذه التغييرات عبر القرون.
واللغات الإنسانية كلها تحدُثُ تغييرات صرفية، في أبنية كلماتها، من زمنٍ إلى آخر. وهو الأمر الحاصل في اللغة العربية، حيث تتغير فيها صيغ صرفية، وتستجد صيغ صرفية أخرى. وذلك؛ تبعًا لمعطيات الزمن وحقبه المتتابعة. علاوةً على أن اللغة العربية تتميز عن أخواتها، بالقدرة على استغلال الجذور الثلاثية، في توليد صيغ جديدة. بل إن ذلك من عبقريتها التي تكاد تنفرد بها(14).
[2ــ2]: الدراسات الصرفية الوصفية
المجال الصرفي، معيارٌ لضبط مفردات اللغة وكلماتها، بأقسامها الثلاثة: الاسم، والفعل، والحرف. وتندرج في إطاره موضوعات: الاشتقاق، وتصريف الأفعال، والنسب، والتصغير، والتعريف والتنكير، وصيغ التذكير والتأنيث، وصيغ المبالغة، والإفراد والتثنية والجمع، والمجرد والمزيد، وأبنية الحروف التي تشبه أبنية الأسماء. وغير ذلك، من الموضوعات الصرفية، التي تزخر بها المصنفات اللغوية، بمختلف المدارس والتوجهات والمذاهب.
ومهمة منهج الدراسات اللغوية الوصفية، هو بحث هذه الجزئيات، بآليات: الوصف، والتحليل، والتفسير، والتعليل.
[2ــ3]: الدراسات الصرفية المقارنة
يهتم علم اللغة المقارن “بدراسة الجانب الصرفي على مستوى الفصيلة الواحدة”(15). بحيث يقف عند ظواهر لغوية صرفية، فيدرسها دراسة مقارنة، حتى يصل إلى اللغة الأم، التي تعود إليها هذه الظاهرة أو تلك.
[3]: الدراسات اللغوية الدلالية والمعجمية
[3ــ1]: الدراسات الدلالية والمعجمية التاريخية
مجال الدلالة والمعجم، كغيره من الجوانب اللغوية، تطرأ عليه تغييرات وتطورات بمرور الزمن، فهو أسرع تطورًا من الجوانب اللغوية الأخرى. إذ تستجد دلالات، وتغيب دلالاتٌ، وتتوسع دلالات، وتضيق دلالات.
[3ــ2]: الدراسات الدلالية والمعجمية الوصفية
حينما يتناول منهج الدراسة اللغوية الوصفي بالدراسة مجال الدلالة والمعجم في لغة من اللغات، يقدم وصفًا معجميًّا لمفردات اللغة. كما يصف المعنى بتعدداته، ومشكلاته، ومراحل تطوره المختلفة. سواءٌ في فترةٍ زمنيةٍ محددةٍ، أو في أكثر من فترة زمنيةٍ، بمساندة المنهج التاريخي.
[3ــ3]: الدراسات الدلالية والمعجمية المقارنة
يتناول الدرس اللغوي المقارن مجال الدلالة والمعجم، تحت مفهومين اثنين:
الأول: (علم الدلالة المقارن)، وهذا “يهتم بدراسة القضايا الدلالية على مستوى الفصيلة الواحدة”(16).
والثاني: (المعجم المقارن) “ويهتم بحصر الكلمات التي توارثتها لغات الفصيلة من اللغة الأم التي تطورت عنها تلك اللغات. وهذا النوع من الكلمات، يسمى “المشترك السامي” بالنسبة للفصيلة السامية، والمشترك “الهندوأوروبي” بالنسبة للفصيلة الهندوأوروبية، والمشترك “الحامي” بالنسبة للفصيلة الحامية”(17).
وهناك من يجعل (علم الدلالة المقارن) عامًّا ودالًّا على المفهومين في آنٍ واحد. ذلك؛ لأن “أهم جانبٍ تطبيقي لعلم الدلالة المقارن هو تأصيل المواد اللغوية في المعاجم”(18).
[3ــ4]: الدراسات الدلالية والمعجمية التقابلية
يتناول الدرس التقابلي في مجال الدلالة والمعجم، الدلالات والمعاني المعجمية بين نظامين لغويين مختلفين. كما يدرس المعاني المختلفة، وطرق التعبير عنها، بين مستويين لغويين مختلفين.
ويهدف الدرس اللغوي التقابلي في هذا المجال، إلى معرفة الفروق الدلالية والمعجمية بين اللغتين اللتين يدرسهما دراسة تقابلية. ذلك؛ لأن كل مجتمعٍ من المجتمعات له طرقه الخاصة في التعبير عن المعاني، وكل لغة من اللغات لها طرقها التعبيرية. إذ تختلف هذه الطرائق باختلاف اللغات والمجتمعات؛ “فالمعاني التي نصَنّف فيها خبرتنا معانِ مقيدة أو معدلة ثقافيًّا ومن ثم فهي تختلف اختلافًا كبيرًا من ثقافةٍ إلى أخرى كما أن بعض المعاني التي توجد في ثقافةٍ ما قد لا توجد في الأخرى”(19).
[4]: مجال الدراسات اللغوية الصوتية
في دراسة أصوات اللغة، نستأنس بمنهج الدراسة اللغوي، الذي نجده أنسب لتحقيق الغاية التي نسعى إلى تحقيقها. من ذلك، أن نتعاطى في دراسة ظاهرة صوتية معينة، بمنهجيّة تاريخيّة، أو وصفيّة، أو تقابليّة.
[4ــ1ــ1]: الدراسات الصوتية التاريخية
تعاقبُ الزمن له تأثيراته الواضحة في الحياة كلها، واللغة جانب من هذه الجوانب. لذلك؛ يجري عليها ما يجري على جوانب الحياة من مؤثرات الزمن. وكما تسري آثار الزمن على المجالات اللغوية: النحو، والصرف، والمعجم؛ تسري على المجال الصوتي. ذلك؛ لأن “الأصوات من الجوانب التي تتأثر كثيرًا بمرور الزمن، وتقلب الأجيال، ولا سيما إذا عاشت اللغة فترات متفاوتة في رقيها الحضاري، ومؤثراتها الثقافية”(20).
[4ــ1ــ2]: دراسة التغيرات الصوتية
دراسة آثار الزمن في مجال الأصوات اللغوية، واحدٌ من اهتمامات منهج البحث اللغوي التاريخي؛ إذ يدرس المنهج التاريخي التغييرات الصوتية، التي تتمثل في “تلك الاختلافات والفروق التي يدركها السامع في أثناء سماعه للصوت الواحد في عدة مواقع من الكلمة، أو منطوقًا من قبل عدة أشخاص”(21).
ويُعَدُّ هذا المجال اللغوي أسرع الجوانب اللغوية تطورًا؛ فاللغة في تطورها الصوتي أسرع وأكثر تنوعًا من تطورها في جوانب الصيغ والنحو والمفردات والأساليب(22). ذلك؛ لأن “الجانب المنطوق في اللغة يمارس حرية أكثر من الجانب المكتوب بالإضافة إلى أن اللغة تصادف في تركيباتها وتجمعاتها الصوتية ظروفًا سياقية لا تظهر في الكلام المكتوب، ولهذا ينفصل الصوت عن صورته ويتطور دونه”(23).
ويقسم علماء الأصوات التغييرات الصوتية، على قسمين: مطلقة، ومقيدة. فالتغييرات الصوتية المطلقة، هي: “تلك التغييرات التي تحدث مع التحول في النظام الصوتي للغة بحيث يصير الصوت اللغوي في جميع سياقاته صوتًا آخر”(24). أما التغييرات الصوتية المقيدة، فهي: “التي تحصل للأصوات مشروطة بتجاورها في سياقات صوتية معينة فيحصل بينها تفاعل وتبادل في التأثير والتأثر”(25). أي أنها “تلك التغييرات التي تصيب الأصوات من جهة الصلات التي تربط هذه الأصوات بعضها ببعض في كلمة واحدة”(26).
واللغة العربية، كغيرها من اللغات، طرأت على جانبها الصوتي تغييرات مثل ما يطرأ على غيره من الجوانب اللغوية؛ إذ “توفرت للغة العربية خلال القرون الماضية مؤثرات تعمل على استقرار صورتها الصوتية، ومؤثرات أخرى تساعد على تغيير ملامح هذه الصورة”(27). والدرس التاريخي اللغوي، هو الذي يبحث هذه التطورات والتغييرات الطارئة، التي تزعزع استقرار هذه الصورة.
[4ــ2]: الدراسات الصوتية الوصفية
تمثل الأصوات الماهية الأولى لأيّة لغة، فاللغة لا تكون بدايةً إلا مجموعة من الأصوات؛ لذلك عرف اللغويون القدماء اللغة بأنها “أصواتٌ يعبر بها كل قومٍ عن أغراضهم”(28). ومن علماء اللغة المحدثين مَنْ يعرفها هذا التعريف بشكلٍ آخر، فهذا العالم اللغوي (إدوارد سابير Edward Sapir)، يعرف اللغة بأنها “ظاهرة إنسانية وغير غريزية لتوصيل العواطف والأفكار والرغبات بواسطة نظام من الرموز الصوتية الاصطلاحية”(29).
[4ــ2ــ1]: الدراسات الصوتية الوصفية القديمة والحديثة
سارت الدراسة اللغوية الصوتية بمحاذاة الدراسة اللغوية في مجالاتها الأخرى، فاهتم بها علماء اللغات منذ القدم. لا سيما علماء اللغتين العربية والسنسكريتية. يقول (فيرث Firth) عن ذلك: “لقد نشأت الدراسات الصوتية ونمت في أحضان لغتين مقدستين العربية والسنسكريتية”(30)؛ إذ اعتنى علماء اللغة العرب القدماء بالأصوات، ابتداءً بمعجم “العين” للخليل بن أحمد(31)، ثم بعده تلميذه سيبويه، فدرس علم الأصوات في كتابه، الذي “يعتبر من أقدم المصادر التي وصفت الأصوات العربية وصفًا تفصيليًّا، يعتمد على تقرير الواقع المعاصر لمؤلفه خلال القرن الثاني الهجري (140 ــ 180 تقريبًا)”(32).
واستمرت الدراسات اللغوية الصوتية عند علماء اللغة. لكنها “لم تدخل في عداد البحوث العلمية الدقيقة، ولم تحظ بما حظيت به البحوث اللغوية الأخرى من الدرس الشامل والبحث المستفيض إلا في القرن التاسع عشر”(33). ومن أشهر علماء اللغة المحدثين، الذين اهتموا بهذا الجانب من الدرس اللغوي منذُ القرن التاسع عشر: (ج. جريم، وبروجمان، وأستوف، وهرمان بول، وجاستون باري). وغير هؤلاء، من العلماء اللغويين المهتمين بهذا الجانب من الدرس اللغوي.
[4ــ2ــ2]: (الصوامت/ الصوائت)
يقسم اللغويون الوحدات الرئيسة لأي لغة، على قسمين اثنين. تختلف تسميتهما فيما بين علماء اللغة؛ فهناك من يُطلق عليهما الصوامت والصوائت(34). في حين يطلق عليهما آخرون، الأصوات الساكنة وأصوات اللين(35). وهناك من يطلق عليهما مصطلحي: الأصوات الصامتة، والأصوات المتحركة(36).
[4ــ2ــ3]: (الفونيم/ المورفيم)
يميز الباحثون في الدراسات اللغوية الصوتية بين مصطلحين اثنين، الأول منهما (الفونيم): وهو “ذلك الصوت الأم ــ إذا صح التعبير ــ الذي يندرج تحته عددٌ من الأصوات، التي تختلف عنه من الناحية الصوتية في بعض الصفات، ولكنها على ذلك تظل تعتبر أحد فروعه”(37). والثاني (المورفيم): و”هو أصغر وحدة لغوية ذات معنى”(38).
[4ــ3]: الدراسات الصوتية التقابلية
يهتم الدرس اللغوي التقابلي في مجال الأصوات، بدراسة نظامين صوتيين في لغتين مختلفتين، بحيث يحدد الفروق الصوتية بين هذين النظامين، لغايةٍ تعليمية؛ فالمتعلم حينما يتعلم لغة أجنبية، يميل إلى نقل نظام لغته بكامله إلى اللغة الأجنبية(39).
والطالب حينما يدرس “نظامًا صوتيًّا للغةٍ أجنبية، يجد أن بعض الأصوات تتشابه من حيث الشكل مع أصوات لغته. كما قد يجد تشابهًا، في بنية الأصوات وتوزيعها أيضًا”(40). أو يجد أصواتًا في اللغة الأجنبية، لا نظائر لها في لغته الأصلية، تختلف من حيث بنيتها وتوزيعها(41).
وبذلك؛ تتضح أهمية الدراسة التقابلية، باعتبارها “وسيلة للتنبؤ بالمشكلات النطقية ووصف ما يتعلق منها بأداء المتكلمين بلغةٍ معينة عندما يدرسون لغة أخرى”(42)، حيث يتضمن رصد هذه المشكلات “أنواعًا من المعالجات اللغوية ربما لا يتسنى دائمًا توافر مادتها”(43).
- محمود فهمي حجازي، “علم اللغة العربية، مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية”. وكالة المطبوعات، الكويت، 1973م، ص: (38). ↩︎
- عباس علي السوسوة، “في النحو التاريخي للفصحى، وملاحظات”. مجلة جذور، النادي الأدبي الثقافي بجدة، العدد (10)، المجلد (6)، رجب 1423هـ ـ سبتمبر 2002م، ص: (96). ↩︎
- عباس علي السوسوة، “دراسة نحو العربية تاريخيًّا: كتاب المؤتمر الثاني للعربية والدراسات النحوية: “العربية وقرن من الدرس النحوي”. جامعة القاهرة، 19،18 فبراير 2003م ـ 18،17 ذو الحجة 1423هـ، ص: (133). ↩︎
- عباس علي السوسوة، “العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية”: دار غريب، القاهرة، 2002م، ص: (16). ↩︎
- عباس علي السوسوة، “دراسة نحو العربية تاريخيًّا”. مرجع سابق، ص: (132). ↩︎
- نفسه. ↩︎
- عباس علي السوسوة، “في النحو التاريخي للفصحى وملاحظات”. مرجع سابق، ص: (96). ↩︎
- عباس علي السوسوة، “دراسة نحو العربية تاريخيًّا”. مرجع سابق، ص: (132). ↩︎
- محمد ربيع الغامدي، “حكايات نشأة النحو”. مجلة جذور، إصدارات النادي الأدبي الثقافي بجدة، العدد (24)، المجلد (11)، جمادى الأولى 1428هـ ـ يونيه 2007م، ص: (160). ↩︎
- نادية رمضان النجار، “فصول في الدرس اللغوي بين القدماء والمحدثين”. ط1، دار الوفاء، الإسكندرية، 2006م، ص: (40). ↩︎
- نفسه، ص: (46). ↩︎
- نفسه، ص: (58). ↩︎
- البدراوي زهران، “في علم اللغة التاريخي، دراسة تطبيقية على عربية العصور الوسطى”. ط4، دار المعارف، القاهرة، د. ت، ص: (8). ↩︎
- عبد الصبور شاهين، “في التطور اللغوي”. ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1405هـ ـ 1985م، ص: (34). ↩︎
- .حازم علي كمال الدين، “علم اللغة المقارن”. مكتبة الآداب، القاهرة، 1420هـ ـ 1999م، ص: (46). ↩︎
- نفسه، ص: (49). ↩︎
- .نفسه، ص: (51). ↩︎
- محمود فهمي حجازي، “مدخل إلى علم اللغة”. دار قباء، القاهرة، 2001م، ص: (21). ↩︎
- محمود إسماعيل صيني، وإسحاق محمد الأمين، “التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء”. تعريب وتحريرـ عمادة شؤون المكتبات، ط1، جامعة الملك سعود، الرياض، 1402هـ ـ 1982م، ص: (61). ↩︎
- عبد الصبور شاهين، “في التطور اللغوي”. مرجع سابق، ص: (182). ↩︎
- جيلالي بن يشو، “بحوث في اللسانيات، الدرس الصوتي العربي المماثلة والمخالفة، مصطلحات المماثلة والمخالفة وظواهرهما في العربية الفصحى”. ط1، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 1428هـ ـ2007م، ص: (24). ↩︎
- برتيل مالمبرج، “الصوتيات”. ترجمة: محمد حلمي هليل. عين الدراسات والبحوث الاجتماعية، 1994م، ص: (197). ↩︎
- أحمد مختار عمر، “دراسة الصوت اللغوي”. ط3، عالم الكتب، بيروت، 1405هـ ـ 1985م، ص: (317). ↩︎
- رمضان عبد التواب، “التطور اللغوي. علله ومظاهره وقوانينه”. ط1، مكتبة الخانجي، ودار الرفاعي. الرياض، والقاهرة، 1404هـ ـ 1983م، ص: (17). ↩︎
- جيلالي بن يشو، “بحوث في اللسانيات”. مرجع سابق، ص: (30). ↩︎
- رمضان عبد التواب، “التطور اللغوي. علله ومظاهره وقوانينه”. مرجع سابق، ص: (22). ↩︎
- عبد الصبور شاهين، “في التطور اللغوي”. مرجع سابق، ص: (182). ↩︎
- ابن جني (أبو الفتح عثمان)، “الخصائص وسر صناعة الإعراب”. تحقيق: محمد علي النجار. ط4، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1999م، جـ1/ ص: (34). ↩︎
- حلمي خليل، “مقدمة لدراسة علم اللغة”. دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1999م، ص: (23). ↩︎
- كمال بشر، “دراسات في علم اللغة”. ط2، دار المعارف، القاهرة، 1971م، قسم2، ص: (67). ↩︎
- عبد الغفار حامد هلال، “علم اللغة بين القديم والحديث”. ط3، مطبعة الجبلاوي، القاهرة، 1989م، ص: (34، 35). ↩︎
- عبد الصبور شاهين، “في التطور اللغوي”. مرجع سابق، ص: (182). ↩︎
- علي محمد غالب ردمان المخلافي، “المنسوب إلى لهجات اليمن في كتب التراث العربي، دراسة لغوية”. إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 1425هـ ـ 2004م، ص: (80). ↩︎
- كمال بشر، “علم الأصوات”. دار غريب، القاهرة، 2000م، ص: (149). ↩︎
- إبراهيم أنيس، “الأصوات اللغوية”. ط4، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1999م، ص: (26). ↩︎
- رمضان عبد التواب، “المدخل إلى علم اللغة، ومناهج البحث اللغوي”. ط2، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1405هـ ـ 1985م، ص: (42). ↩︎
- نايف خرما، “أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة”. سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد (9)، سبتمبر 1978م، ص: (220). ↩︎
- نفسه، ص: (110). ↩︎
- محمود إسماعيل صيني، وإسحاق محمد الأمين، “التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء”. مرجع سابق، ص: (169). ↩︎
- نفسه، ص: (17). ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه. ↩︎