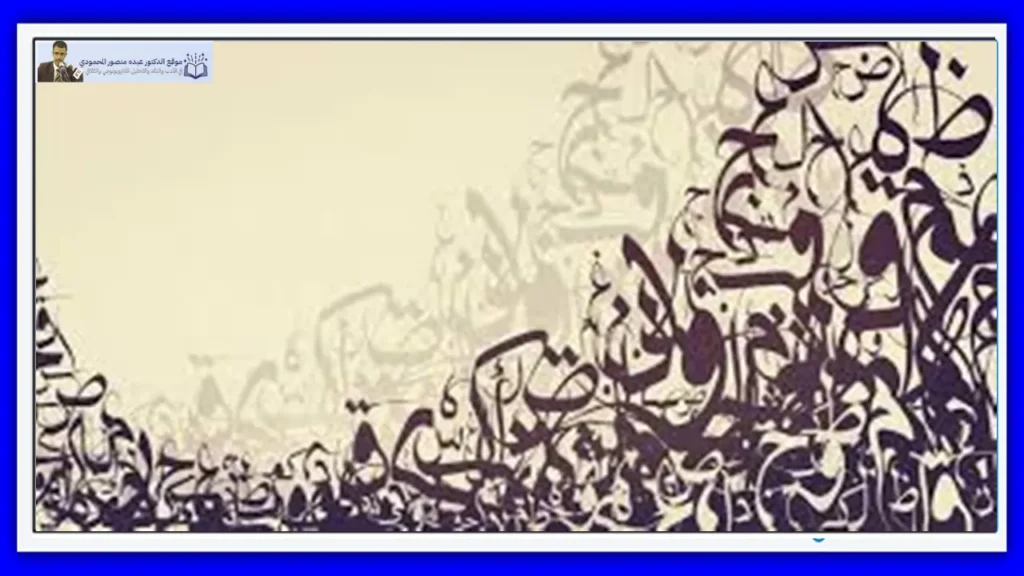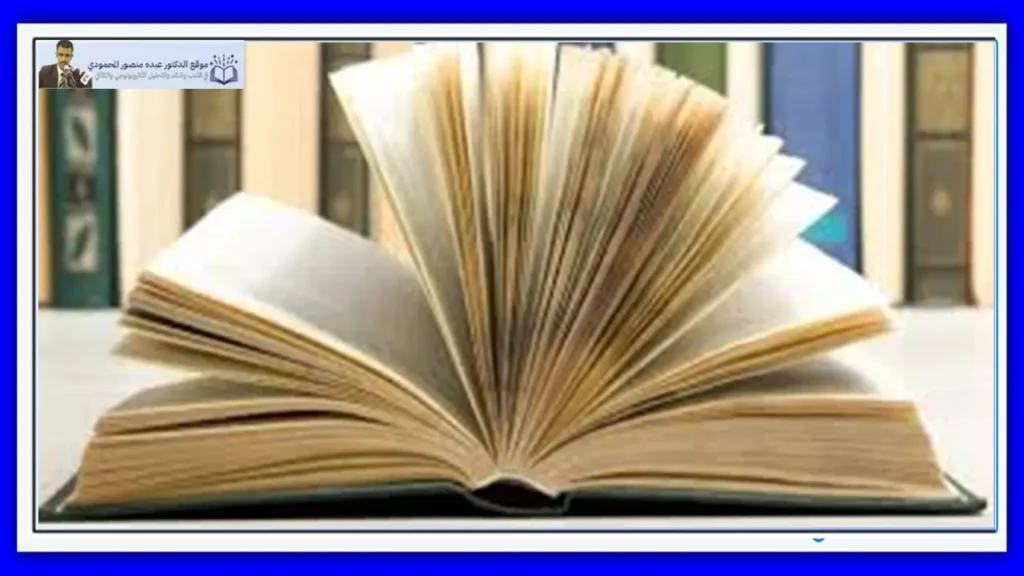الدرس اللغوي العربي الحديث
تتعدد التجارب العربية في الدراسات اللسانية الحديثة، وتختلف باختلاف البُنية الفكرية والمعرفية لدى أصحابها. ولعل من أهم هذه التجارب تجربة أستاذ اللسانيات في جامعة تعز الأستاذ الدكتور عباس بن علي السوسوة، الذي قدم ــ ولا يزال يقدم ــ إسهاماتٍ بارزة في الدرس اللساني العربي الحديث، مستأنسًا بآليات وأدوات منهجية متسقة مع الغاية التي يسعى إلى تحقيقها في دراساته وأبحاثه اللغوية.
[1]: السوسوة والمنهج الوصفي
درس الدكتور عباس السوسوة ــ في عددٍ من دراساته وأبحاثه اللغوية ــ موضوعات وظواهر نحوية، باستخدام إجراءات وآليات المنهج الوصفي. سواءٌ تلك الظواهر المنتمية إلى العربية الفصحى، أو المنتمية إلى لهجات العربية المحكية.
ولأن منهجي الدراسة اللغوية التاريخي والوصفي يرتبطان بعلاقاتٍ إجرائية وثيقة؛ فإن السوسوة يتفق مع القائلين بأن لا اختلاف جوهري بينهما، كون كل وصف هو في حقيقته تاريخ بشكل أو بآخر. لذلك؛ يرى أن “المنهج التاريخي لا يقوم إلا على وصفٍ مسبق، فالتاريخي هو عبارة عن مجموعة أوصاف … وصحيحٌ أن المنهج الوصفي لا يُظهر في البداية ما يسمى نتائج عظيمة، لكن إذا كثرت الأوصاف أدت إلى نتائج”(1).
[2]: السوسوة والمنهج المقارن
للمنهج المقارن حضوره المحدود في اشتغالات الدكتور عباس السوسوة على الظواهر اللغوية. بما في ذلك حضور هذا المنهج في رؤاه التنظيرية لهذا المنحى المنهجي من الدرس اللغوي.
[2ــ1]: السوسوة واتجاها المنهج المقارن
يسير المنهج المقارن في اتجاهين: الأول، يتمثل في “حصر الدراسة المقارنة في إطار الفصيلة اللغوية الواحدة”(2). والثاني: “تعدى حدود الفصيلة اللغوية الواحدة، واهتم بدراسة الجوانب اللغوية في أكثر من فصيلة”(3).
وهناك من يتحسس من الاتجاه الثاني، ويرى أن المنهج المقارن مختصٌ فقط بدراسة لغات فصيلةٍ واحدة. لكن السوسوة لا يتحسس من ذلك، بل يرى إمكانية مد المقارنة إلى فصائل أخرى، متفقًا مع الأب أنستاس ماري الكرملي. إذ يقول في واحدٍ من أبحاثه: “لكن دعنا نخرج من نطاق المنهج المقارن الذي يدرس مجموعة لغات منتمية إلى فصيلة أو أسرة لغوية واحدة… ونتساءل مثل الأب الكرملي: لِمَ لا نجرب توسيع نطاق هذه المقارنات بالخروج على ما اصطلحنا على تسميته بالأسرة اللغوية الواحدة؟”(4). وبالفعل هناك من جرب ذلك؛ فقد قام الباحث حازم علي كمال الدين في كتابه “علم اللغة المقارن” بدراستين تطبيقيتين في مجال الدلالة، بناءً على هذا الاتجاه(5)..
[2ــ2]: محدودية الدرس اللغوي العربي المقارن
إذا كان الدرس اللغوي المقارن غضًّا في الدراسات اللغوية العربية؛ فإنه، كذلك، لم يحظَ عند عباس السوسوة، بالاهتمام الذي حظي به المنهجان الوصفي والتاريخي. يبين ذلك ويبرره، بقوله:
“المنهج المقارن لا أستخدمه كثيرًا، وسبب ذلك أن هذا المنهج يحتاج إلى معرفة ــ على الأقل ما يختص في العربية ــ يحتاج إلى معرفة كبيرة باللغات السامية، أنا ليس عندي هذه المعرفة الكبيرة. أعرف قليلًا، لكنها معرفة لا تكفي لإقامة منهجٍ مقارن. ورحم الله امرءًا عرف قدر نفسه! … كنت أضطر إليه اضطرارًا، أحيانًا في الدراسة التاريخية في مجال المحكية، وكنت أستعين في ذلك ببعض أساتذتي الذين لهم علم بالساميات”(6). لذلك؛ جاءت إسهامات السوسوة، في هذا الفرع من الدرس اللغوي قليلة، وإشاراتٍ مقتضبة في مواضع من دراساته وأبحاثه.
[3ــ1]: السوسوة والمنهج التقابلي
درس الدكتور عباس السوسوة دراسة لغوية تقابلية بعض الظواهر اللغوية: نحوية، وصرفية، ومعجمية، وصوتية. سواءٌ في الفصحى، أو في المحكية؛ إذ كان المنهج التقابلي واضحًا بصورةٍ رئيسة في كتابه “دراسات في المحكية اليمنية”. وإن كان لديه إشارات تقابلية في مواطن أخرى من كتاباته ودراساته، في غير هذا الكتاب. ولأن الكتاب خاصٌ بدراسة المحكية اليمنية، فقد كان اهتمام الدراسة التقابلية عنده بالمحكية اليمنية بدرجةٍ رئيسة؛ فقابل بعضًا من ظواهرها اللغوية بالفصحى وبلهجاتٍ عربية، وباللغتين: الإنجليزية، والفرنسية، وكذلك، باللغة الهندية.
[3ــ2]: مصاحبة حروف الجر للأفعال والمصادر
لم يعتمد عباس السوسوة المقاييس التقابلية منهجًا متكاملًا في أيِّ من دراساته. لكنه أحضرها في دراسة جزئيات أبحاثه، التي خصها للظواهر اللغوية ذات الطبيعة التقابلية في انتماءاتها. لذلك؛ حفلت تلك الجزئيات بإشاراتٍ مهمة، إلى توظيفه المنهج التقابلي في تلك الدراسات. من مثل ما يتعلق منها، بالمقابلة بين العربية الفصحى ــ المعاصرة تحديدًا ــ ولغاتٍ من لغات أسرة اللغات الهندية الأوروبية.
[3ــ2ــ1]: مقابلة مصاحبة حروف الجر للأفعال والمصادر بين العربية الفصحى واللغتين: الإنجليزية، والفرنسية
في دراسة السوسوة لظاهرة “المصاحبة”، في العربية الفصحى المعاصرة، تطرق إلى مصاحبة حروف الجر للأفعال والمصادر. ومن هذه المصاحبة، ظاهرة مصاحبة الفعلين: “أثر” و “أكد” لحرف الجر في العربية الفصحى المعاصرة. ذلك؛ باعتبارها سمة من سمات العربية الفصحى المعاصرة. وينقد من يقول إنها متأتية من التأثر بالترجمة الأوروبية، ويبرهن عدم صحة هذا القول بإجراءاتٍ تقابلية.
[3ــ2ــ1ــ1]: مقابلة بين اللغتين العربية والفرنسية
يقابل السوسوة بين العربية والفرنسية، في تناوله لمصاحبة الفعل “أثر” لحرف الجر، مفندًا مقولة التأثر بالترجمة الأوروبية، قائلًا: “نحن نرى في هذا القول تسرعًا، لسببٍ بسيط جدًّا هو أن الفرنسيين لا يستعملون مع هذا الفعل حرف جر بعده، إذ هو فعل متعد إلى المفعول بنفسه”(7).
ويأتي بأمثلةٍ من “أحد المعاجم الفرنسية المعتمدة التي تأتي بأمثلة لا يلحق بالفعل يؤثر (Influencer) حرف جر أصلًا”(8). ومن هذه الأمثلة التي أوردها، هذا المثال:
Maladie à influencé ma santé La”
وترجمتها الحرفية: المرض أثر صحتي”(9). أي “أنها أشبه شيء بالنصب على نزع الخافض عند النحاة العرب”(10).
ويضيف ــ أيضًا ــ أن “في الفرنسية أفعالًا تستخدم في معنى التأثير كالفعل السابق، ولا يلحق بها حرف جر أصلًا، مثل: inflechir و effecter”(11).
[3ــ2ــ1ــ2]: مقابلة بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية
ويقابل السوسوة ــ أيضًا ــ في دراسته هذه الظاهرة، بين اللغتين: العربية والإنجليزية. ويصل إلى عدم مصاحبة الفعل “يؤثر” في الإنجليزية لحرف الجر، فيقول: “وإذا تركنا الفرنسية إلى الإنكليزية وجدنا الفعل (Influence) يقابل الفعل العربي (يؤثر) ولا يلحق به حرفٌ من أي نوع”(12).
[3ــ2ــ1ــ3]: مقابلة الفعل “أكد” بين العربية واللغتين: الفرنسية والإنجليزية
كما تناول السوسوة مصاحبة الفعل “أثر” لحرف الجر، كان تناوله لمصاحبة الفعل “أكد” لحرف الجر في العربية الفصحى المعاصرة، واللغتين: الفرنسية والإنجليزية. وكما لا يلحق حرف الجر الفعل “أثر” في اللغتين: الفرنسية، والإنجليزية، لا يلحق الأفعال الدالة على معنى الفعل “أكد” في هاتين اللغتين، وأورد أمثلة لذلك.
مما أورده في الفرنسية، هذان المثالان، اللذان يبرهن بهما على عدم تأثر العربية الفصحى المعاصرة بالترجمة:
المثال الأول: “أؤكد موقفي J’affirm ma position”(13).
ويعلق عليه، بقوله:
“وهذا لا يلحقه حرف جر وكذلك الاسم منه affirmatiom”(14).
والمثال الثاني: “أؤكد الرواية: je confirm la novell”(15).
ويوضح ذلك، قائلًا:
“الفعل confirmer والاسم منه “confirmation لا يلحق بهما حرف جر أيضًا.
وكذلك الفعل “assurer” والاسم منه “assurance””(16).
[3ــ1ــ1ــ4]: الفرق بين العربية واللغتين الفرنسية والإنجليزية
يصل السوسوة ــ من خلال هذه الإجراءات التقابلية البسيطة ــ إلى تحديد الفرق بين العربية وهاتين اللغتين. ويوضح ذلك، بقوله: “فإذا أدركت من العرض السابق أن الأفعال الإنكليزية المستخدمة للتأكيد لا يلحق بها ما يكافئ حرف الجر (على) في العربية، وأن الأفعال الرئيسية الأكثر شيوعًا في معنى التأكيد في الفرنسية لا يلحق بها ولا بأسمائها حرف جر؛ علمت أن هذه العبارة “أكد على” ليست بتأثير الترجمة عن اللغات الأوروبية الحديثة”(17).
- من المقابلة التي أجراها معه الكاتب، تعز، يوم الأربعاء: 16 جمادى الأولى 1429هـ ــ 21 مايو 2008م. ↩︎
- حازم علي كمال الدين، “علم اللغة المقارن”. مكتبة الآداب، القاهرة، 1420هـ ـ 1999م، ص: (132). ↩︎
- نفسه. ↩︎
- عباس السوسوة، “ملاحظات مفتش نظافة سويسري”. مجلة جذور، النادي الأدبي الثقافي بجدة، العدد (6)، مجلد(3)، رجب 1422هـ ـ سبتمبر 2001م، ص: (515). ↩︎
- ينظر: حازم علي كمال الدين، “علم اللغة المقارن”. مرجع سابق، ص: (214ـ 220). ↩︎
- من المقابلة التي أجراها معه الكاتب، تعز، يوم الأربعاء: 16 جمادى الأولى 1429هـ ــ 21 مايو 2008م. ↩︎
- عباس السوسوة، “العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية”. مرجع سابق، ص: (200). ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه، ص: (201). ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه، ص: (204). ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه، ص: (205). ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه ↩︎