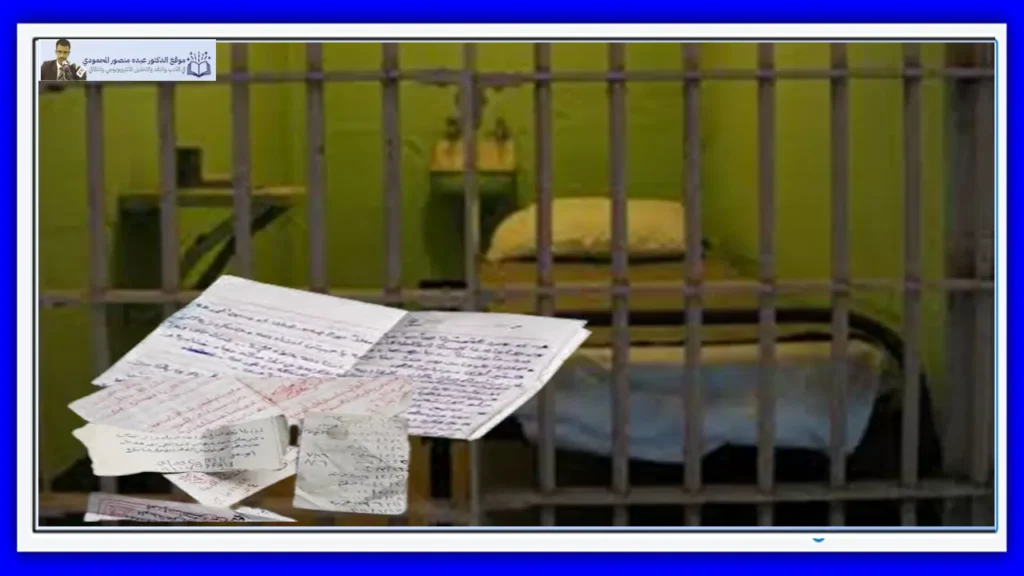المرأة والتغريبة المنسية في رواية عمى الذاكرة
على الرغم من أن “التغريبة المنسية” ليست سوى عنوان واحدٍ من فصول رواية الكاتب حميد الرقيمي “عمى الذاكرة”(1)، إلّا أنها هي البعد السرديّ المهيمن على المتن الروائي. كما أن هذه التغريبة هي السياق المحوريّ، الذي تماهت فيه المضامين السردية. بما في ذلك ما يتعلّق بالحضور البارز لأحوال المرأة، في سياقات سرديّةٍ متعددة، تارة ذات خصوصية يمنية، وأخرى ذات هوية إنسانية عامة، متّصلة بواحديّة البؤس، المتخلّق من رحم الصراعات المحتدمة في عددٍ من البلدان والشعوب.
[1]: تغريبة اليمنيين
[1ــ1]: الهجرة المأمولة
قام تسريد الأحداث ــ في هذا العمل ــ على التعاطي مع فكرة سردية رئيسة، تمثّلت في هجرة اليمنيين وشتات ترحالهم في أصقاع الأرض؛ إذ استوعبت الرواية هذه الفكرة، من خلال اشتغالها على تسريد سياقات مختلفة من حياة شخصيتها الرئيسة يحيى، الذي فقد والديه في طفولته، إثر اندلاع واحدة من دورات الصراع في اليمن، فعاش في كنف أسرة أخرى. ثم غادر قريته إلى مدينة صنعاء؛ لمواصلة تعليمه الجامعي. أقام فيها فترة محدودة، ثم غادرها مهاجرًا خارج الوطن، بعد أن تعرضت المدينة والبلد لعاصفة صراعٍ جديد.
تداعى يحيى مع أحلام الهجرة إلى أوروبا، فشد الرحال إليها مع غيره من الحالمين. وقبل وصول قاربهم إلى شواطئ إحدى المدن الإيطالية احترق بمن فيه، ونجا يحيى بأعجوبة، تلقى بعدها العلاج في إحدى المدن الإيطالية.
[1ــ2]: الفكرة السردية والحيّز السردي
يتسم تسريد الأحداث، بنوع من الامتداد الخطي في حيزه السردي؛ إذ بدأ الزمن السردي من مطالع العقد الأخير في القرن العشرين الفائت، وصولًا إلى العقد الثاني من الألفية الثالثة. كما قام بناء هذا الزمن، على نسقٍ من المواربة الجمالية، التي تجسّدت في الإحالة على هذا الحيز السرديّ، من خلال عددٍ من الأحداث البارزة التي حدثت فيه، فأطّرتْه ــ زمنيًّا ــ بشكلٍ أغناه، عن إيراد أيّةِ إشارةٍ تاريخية إلى تلك الأحداث.
أمّا خطُّ الامتداد السرديّ للحيز المكاني، فيتّضح استهلالُه من القرية التي وُلِدتْ فيها الشخصية الرئيسة، على ما في الإشارة إلى تلك القرية من إبهامٍ، بدأ في الانحسار النسبيّ مع إيراد مدينة صنعاء مكانًا جديدًا انتقل إليه يحيى. ثم مثّلت هجرته من المدينة استمرارًا لهذا الخط السردي المكاني، الذي امتد إلى مدنية عدن محطةً جديدة من محطات ترحاله. تلتها مدينة القاهرة في مصر، ثم مدينة الخرطوم في السودان، وبعدها مدينة مصراته في ليبيا، وصولًا إلى إيطاليا.
لقد جاء الحيز السردي المكاني نسقًا استيعابيًّا لمسارات تسريد فكرة الرواية وموضوعها السردي، بشكلٍ فاعلٍ في الكشف عن محورية الفكرة الروائية في صياغة العناصر السردية. تجلّى ذلك في الحيز المكاني، الذي استوعب صورًا من تغريبة اليمنيين، في شارع فيصل المكتظ بهم في القاهرة(2)، ومثله غيره من شوارع المدينة المأهولة بكثير من المطاعم والمحلات اليمنية(3). والأمر نفسه، في ملاحظة يحيى عددًا من المطاعم اليمنية، في مدينة الخرطوم(4).
[1ــ3]: الفكرة السردية والشخصية الروائية
تتجلّى محورية الفكرة السردية ــ أيضًا ــ في ارتباط شخصيات العمل ارتباطًا مباشرًا بها؛ إذ جمعت الهجرة بين يحيى وزملائه اليمنيين، الباحثين مثله عن ملاذ من مأساة بلدهم: لطفي، وياسر، ومحمد، وطه. كما تجلت محورية هذه الفكرة في حياة عددٍ من شخصيات العمل، من خلال استقطابها كل باحث عن بلد الأحلام؛ إذ عُزِّزَتْ مجموعةُ اليمنين المهاجرين بمهاجرين عرب وأفارقه. وبذلك؛ قدّمت الرواية فكرة الهجرة والشتات، بوصفها سياقًا عالميًّا؛ تفضي إليه الصراعات، التي تتمزق بها كثير من الأوطان.
ويُلاحظ أن هيمنة فكرة الهجرة لم تقتصر على استقطاب الشخصيّات التي تفكر فيها، بل امتدت لتشمل السائق السوداني عوض، الذي نقل يحيى وزملاءه من السودان إلى ليبيا، لم يكن يفكر في الهجرة، لكنه حينما وصل بهم إلى مدينة مصراته، فضّل البقاء معهم، والانضمام إليهم في هجرتهم. وبذلك، بلغت حيوية الفكرة الروائية، أعلى مستويات فاعليتها، في صياغة العناصر السردية.
[2]: المرأة في أُتون الصراع
يتجلى الحضور الملحوظ ــ الذي نالتْه المرأة في هذا العمل ــ منذ صفحاته الأولى؛ إذ تضمّنت صفحة إهدائه إشارة المؤلف، إلى المرأة مشمولةً بمن أهداه إليهم: “إلى زوجتي المخلصة رباب، إلى طفلتي وبهجة فؤادي”(5). ثم احتفى المتن السردي بعددٍ من الشخصيات النسائية. سواء تلك التي ارتبطت ارتباطًا مباشرًا بالشخصية الرئيسة يحيى، أو تلك التي وردت في سياقات محورية فاعلة في محيطه الاجتماعي، ومثلها تلك الشخصيات، المنتمية إلى عددٍ من البلدان المنكوبة بكارثة الصراع وتداعياته.
[2ــ1]: المرأة اليمنية في حياة الشخصية الرئيسة
[2ــ1ــ1]: المرأة أمًّا مفقودة
[2ــ1ــ1ــ1]: منزوعة القرار
استمدت الرواية عددًا من شخصياتها النسائية ــ المرتبطة بشخصيتها الرئيسة (بدر/ يحيى) ــ من السياق اليمني الواقعي، المحكوم بالسلطة الذكورية، وما يتعلق بها من مصادرة لحق المرأة في الرأي واتخاذ القرار. من ذلك ما قام عليه تسريد اتّخاذ قرارِ تسمية هذه الشخصية فور ولادتها؛ إذ اضطلع الأب بذلك، واكتفت الأم باستفساره عن مغزى التسمية، غير مفرّطة في معايشة سعادتها: “تبتسم أمك وهي تتأملك بصمت… خرجت أمك باسمة في وجه أهلها وصديقاتها، تحملك أينما ذهبت”(6).
[2ــ1ــ1ــ2]: بين أنقاض الصراع
في سياق تسريد الصراع وتداعياته في مجتمع الشخصية، يظهر نصيب المرأة من المأساة؛ إذ تشارك الرجل في احتساء مرارة النهاية، في مشهد أُزهقت فيه روح أم بدر وأبيه، حينما دُمّر منزلهم في واحدةٍ من صور كارثة الصراع، بمعية كثير من المنازل المحيطة به. كان بدر تلك اللحظة على مقربة من المنزل، لكنه لم يصل إليه إلّا وقد انهد على والديه، حاول تلمس الحياة في أمه فلم يجدها، بينما سمع أباه يناديه باسمه لآخر مرة قبل ارتقاء روحه إلى السماء.
وقد كانت اللغة السردية طافحة بالحزن والمرارة، وهي تصور تلك اللحظة وأثرها المأساوي في نفس الولد المكلوم، الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره: “تصرخ بصوت رجولي لم تكن تملكه، تنام على صدر أمك، لا تستريح، تجمعهما في مكان واحد، وتنام بينهما، تضع سواعدهما على صدرك، تبكي وحيدًا، تشاهد السماء وقد تحولت إلى سوداء خالية من كل شيء، لا نجوم ولا قمر ولا غيوم ضبابية تدلك على الحياة، كأنها في مأتم”(7).
توافَدَ الناس لرفع الأنقاض والبحث عن أحياء، لكنهم لم يجدوا سوى بدر، فتكفّل أحد أصدقاء أبيه برعايته، وكلف ابنه سالم ــ الذي فقد زوجته في اليوم نفسه وبالكارثة نفسها ــ بالزواج من لطيفة لترعى الولد، فلم يجد مناصًا من تنفيذ رغبة أبيه. عاش بدر في كنف أسرته الجديدة، التي منحتْه اسمه الجديد يحيى. يقول الجد عن ذلك ليحيى في وقت لاحق: “عندما تزوج [سالم من] لطيفة في هذه القرية كان ذلك بطلب مني، وكان ذلك أيضًا من أجل أن تحتويك… كان لا بد من أم ترعاك، وأب يحتويك، وجدٍّ يدلك على الطريق”(8).
[2ــ1ــ1ــ3]: فريسة الهجر والغياب
كانت المأساة قاسية على سالم، فلم يستطع التعايش معها، وغاب كثيرًا عن زوجته الجديدة لطيفة، وعن يحيى الذي صار أبا افتراضيًّا له كما صارت لطيفة أمه البديلة. يقول الولد، عن ذلك: “كان هذا الأمر يقلق أمي ويجعلها تتحاشى الحديث عنه، لم تكن تسأله عن غيابه ولم تكن تحاكمه على تقصيره الواضح الذي يعرفه كل فرد في الأسرة، يعود كأن شيئًا لم يحدث، لا فرحة مرسومة على وجهه ولا عناق يعوض به أمي عن هجرانه المبهم… أمي بالكاد كانت تقف على نفسها، تأخذها مشاغل البيت طوال اليوم، وتولينا اهتمامها”(9).
وفي هذا السياق السرديّ تتجلّى حال المرأة الزوجة، ومعاناتها مرارة هجْرِ الزوج وقسوته، متصالحةً مع وضعه البائس، ومتصالحة ــ أيضًا ــ مع وضعها الذي حتَّمَ عليها القبول به زوجًا: “تزوج بها دون أن يقتنع بالأمر… كانت تقول إن سالم لم يرغب بها… ومع هذا كان عليها أن تقبل به، وأن تعيش معه تحت سقف بالكاد يجمعهما”(10).
أمّا الولد، فقد تصالح مع حاليهما، ومع واقعه الجديد؛ إذ استوعب المتغيرات التي أفضت به إلى مصيره ولدًا لأمٍ ليست أمه وأبٍ ليس أباه. وباستيعابه لذلك، نمت مشاعر حبه لهما، لا سيما لطيفة، التي وجدها ماطرةً بحبها له، وحنانها وعطفها عليه، وحرصها على ألّا يتعرض لأي أذى، وتعاليها على جراحها مُتَّخِذَةً من الغناء فضاءً للترويح عن حزنها: “كانت تغني بصوت ملائكي لم أسمعه من قبل… كانت وحيدة مثلي، لا أخ يأتيها ولا أب يزاورها، ومع هذا لم تخُر قواها، في ذروة فرحها المباغت أخرجت من روحها كل خباياها العظيمة، شعرت بأنها تخاف أن أقبل على عمل يؤذيني، كانت خشية مبهمة تدفعها للنبش في فردوسها حتى تضعه في قلبي، وقد نجحت منذ ذلك الصباح البهيج، غنَّت حتى خِلْتُ بأن السماء قد تسقط فرحة على وقع صوتها العذب”(11).
[2ــ1ــ1ــ4]: أيقونة التعويض والسخاء
لقد كانت لطيفة ضحية الصراعات المحتدمة، التي تركتْها امرأةً وحيدةً لا أهل لها، فكان زواجها من سالم ملاذًا لها من حياةٍ بائسة، فرضتها تداعيات الصراع على كثير من نساء اليمن. وقد وَجَدَتْ في يحيى عزاءً، يعوضها عما لم تنَلْهُ من إشباعٍ لغريزة الأمومة: “أنتَ ولدي، جميعنا نحبّك”(12). كما وَجَدَ فيها يحيى تعويضًا له عن حنان أمه الراحلة: “كانت أمي تمسح على رأسي، حتى تراخت ركبتاي بين قدميها وأنا أقول بصوت عال: “أنت أمي، أنت أمي، كل شيء في هذه الدنيا”، كنت أحضن قدميها بشدة، وكانت عاجزة عن حملي، تبكي كما لو كانت تذرف دمع عمرها كله”(13).
بعد وفاة أب سالم، ووصول يحيى إلى سن تقتضي مغادرته القرية إلى المدينة لمواصلة تعليمه الجامعي، تجلّى نُبْلُ المرأة في سخاء لطيفة دعمًا لولدها، مثلها كمثل غيرها من نساء اليمن، في سخائهن لأبنائهن المحتاجين إلى ما يعينهم على مواصلة مشوارهم التعليمي: “كان قرار السفر إلى العاصمة مفاجئًا لأمي، لكنها لم تعترض، أخرجت ما كانت تخبّئه من ذهب وسلّمتني إيّاه، ورغم أنني رفضت بشدة، فقد ألحت وهي تدنو مني باكية وفرحة في الآن نفسه”(14).
[2ــ1ــ2]: الحبيبة تعويض لم يكتمل
تظهر المرأة حبيبةً ليحيى في فترة التحاقه بالجامعة، متخصصًا في دراسة القانون. كانت تلك الحبيبة هي زميلته يافا، التي بدأت علاقتُها معه من موقف طريف، أغدقت فيه بإشفاقها عليه: “هذا يحيى بالكاد يلملم أسماله؛ ماذا يمكن أن يفعل في المرافعات والقضايا الكبيرة”(15).
لكنها غيرت رأيها فيه، بعد أن أحرز تقدمًا في تعليمه وتفوَّق عليهم، تقرّبت منه، واعتذرت منه. ثم نمَتْ تجربة الحب بينهما؛ إذ كان مدفوعًا إليها بحاجته إلى امرأة تعوِّضه عن حنان الأمومة المفقود: “كانت حاجتي للمرأة تمثل حاجتي لحنان الأم الذي لم أعرفه مطلقًا، وهذا استدعى جانبًا آخر مني وأنا أتأمل يافا كل يوم وأمنِّي النفس بأن تكون من نصيبي”(16). أمّا الحبيبة فلم تخطر في بالها هذه الحقيقة: “لم تكن تعرف بأنني كنت أبحث في وجهها عن ذاتي، عن صوت أمي”(17).
كانت تجربة الحب التي عاشها يحيى ويافا استثنائية، بما وصلت إليه من مستوىً متجاوزٍ عاطفةَ الحبّ إلى فضاء أشمل من المودة. يقول عن ذلك: “وقفت علاقتنا في قالب ساكن، كانت الزمالة والجدية التي تفرضها يافا تجعلنا نفكر بما هو أكبر من الحب، ربما الاحترام، وهذا ما دفعنا إلى مرحلة متقدمة من الألفة والمودة”(18).
وعلى هذه الاستثنائية في هذه التجربة العاطفية، إلّا أنها لم تستمر؛ إذ اختفت الحبيبة في كارثة صراعات جديدة، ضربت البلد، وتناسلت في الواقع اليمني البائس؛ فاضطر يحيى إلى الهروب من صنعاء، باتجاه المجهول خارج الوطن.
[2ــ1ــ3]: المرأة أطياف الذكرى
تضمّنت السياقات السردية عددًا من الأحوال التي تلاشت فيها المرأة من حياة يحيى؛ فبعد حرمانه من الأم الحقيقية والبديلة، فَقَدَ الحبيبة يافا، التي يئس من الوصول إلى أي أمل في معرفة مصيرها، فتحوّلت المرأة لديه إلى أطياف ذكرى، تطل عليه بين الحين والآخر. بدءًا من اختفاء الحبيبة، الذي قذفه في حيرة موحشة، فآنستْه ذكرى أمه البديلة، في إحدى ليالي صنعاء: “تأخذني الذاكرة إلى لطيفة، وأسأل نفسي: كيف استطعت أن أقفل هذا الباب نهائيًّا، مشيَّعًا بذلك أمي التي ربّتني سنوات”(19).
غادر صنعاء، فأطلت عليه أطياف المرأة الأم في أوَّلِ مُدِنِ ترحاله؛ إذ لامس ذكرى أمه في شواطئ عدن: “لم أعرف البحر قبل هذا اليوم، ولم ألمس نسيمه من قبل، كنت كمن يلتهم رحيقًا وأنا أفتح فمي للنسمات وأشهقها بعمق، الزفير الذي خلتُه دائمًا مليئًا باللهب كان يخرج باردًا كلمسة أم، نعم أتذكر لمسة أمي”(20).
وحينما وصل إلى السودان في طريق هجرته، لاحت له المرأة من نافذة الذكرى، في هيئة تلك الأم البديلة، التي لم يكلف نفسه الذهاب إلى وداعها، في سياق من الاعتراف بالجحود الذي يُقابَلُ به سخاءُ المرأة الأم: “تلك المرأة المسكينة لطيفة… كيف غادرتُ دون تلويحة وحيدة تعيد إليها ولو القليل من الجميل، كيف هربت بصمتي وخوفي دون لمسة وداع كان لا بد منها، تهاجمني الأسئلة وأنا معها لا أقدر على التجاوب المريح”(21).
أمّا المرأة الحبيبة، فقد لاحت له طيفًا، في أخطر المواقف التي مرّ بها في هجرته بمعية جمع من ضحايا الصراعات في بلدان مختلفة. أولئك الذين جمعتْهم المأساةُ على قاربِ كارثةٍ، شقّ بهم البحر، استشعر يحيى هول ما هو فيه من بؤس جماعي، فلاذ بذكرى الحبيبة: “السماء مكفهرة يتوسطها قمر واضح المعالم، تذكرت كل شيء حينها، هربت إلى حضن يافا التي غادرتُها دون أن أعلم مصيرها”(22).
[2ــ1ــ4]: المرأة فاتحة المصير الجديد
احترق قارب الهجرة بمن فيه، وكُتبت النجاة ليحيى، فكانت المرأة في انتظاره، طبيبةً ومواسيةً؛ إذ وجد نفسه بين مجموعة من الطبيبات الإيطاليات، اللواتي وصل به إليهن أولئك البحارة الإيطاليون، الذين لم يجدوا غيره ناجيًا. ثم استقر مصيره في رعاية واحدة منهن، طبيبة نفسية، تتحدث عربية مكسّرة، كُلفت بالعناية به نفسيًّا حتى يتخلّص من كوابيسه. تحدث معها عن حكايته المأساوية، “وعندما سألتني: هل كان الأمر يستحق كل هذه التضحية؟ بكيت”(23). إذ وجد في استفسارها كثافة المعنى المأساوي، الذي لم يدع له مجالًا للرد عليها، سوى بانفجاره باكيًا حظه العاثر، مُدركًا ــ تلك اللحظة ــ فداحة الوهم الذي استدرجه إلى تلك المحطات الكارثية.
[2ــ2]: المرأة الموازية لحياة الشخصية الرئيسة
لقد تمثّلت أهم تجليات المرأة، في سياقات حضورها في حياة يحيى. وعلى ذلك، فقد نالت حضورًا متعددًا في مواضع مختلفة، أحالت على كينونتها المعذبة في سياقها الإنساني العام، بدءًا بالمرأة اليمنية، وانتهاءً بكل امرأة مُعذبة في هذا العالم.
[2ــ2ــ1]: المرأة اليمنية وأنياب الصراع
علاوة على ما تجرّعته المرأة اليمنية في حياة يحيى، من مرارة الصراع وتداعياته الكارثية، فإنها قد تجرّعت ألوانًا من تلك المرارة في عددٍ من السياقات السردية الموازية لحياة هذه الشخصية. من ذلك، فقدانها للمعيل، وما يترتب على ذلك من أحوال الفقر، التي لا قدرة لها على مواجهتها: “النساء منكسرات على ضعفهنّ ولا تقوى دعواتهنّ على شيء”(24).
ومثل ذلك هو الأمر في قضاء الصراعات على المرأة، في حكاية الأكاديمي اليمني، الذي نال درجة الدكتوراه في الفلسفة. لكنه لم يجد في بلده أحدًا يفقه ما يقول، بل صار هدفًا للسخرية والازدراء. وحدها زوجته من آمنت به وآزرتْه، لكنه صُعِقَ بمغادرتها الحياة بين أنياب الصراع، فغادر البلد تائهًا في شوارع القاهرة(25).
من ناحية أخرى، صادرت الصراعات أحلام الطلبة الجامعيين، الذين تخرجوا، فوجدوا أنفسهم في أتون الحاجة والشفقة الأسرية والازدراء الاجتماعي، فتجلّى دور المرأة مُتَّسِقًا مع الموقف العائلي منهم. من ذلك موقف أم طه من حاله البائسة، بعد تخرُّجه بشهادة جامعية، علّقها في مجلس والده، فعذّبتْه العطالة والإشفاق والحاجة: “انزويت عن المجتمع بخيره وشره، كانت نظرة أمي في الصباح تصيبني بالرعب، أشعر بأنها غير راضية، تنظر إليَّ بشفقة، وفي كل يوم تطلب مني الخروج للبحث عن عمل”(26). لقد تداعت الأم مع موجة الشفقة، التي أرّقت ابنها الشاب، فقرر الهجرة هروبًا من هذا الجحيم، مرافقًا يحيى في رحيلهم المأساوي.
ومثل طه كان رفيق الهجرة محمد، الذي كان لتداعيات الصراع في حياة المرأة اليمنية دورها في دفعه إلى مغادرة الوطن، بعد موقفٍ أراد فيه أبوه إجباره على الانخراط معه في ساحة الصراع. حاولت أمه إثناء والده، لكن الأب الغاضب صفعها، ثم أجهز على حياتها. خرجت ابنتها لترى ما حدث، فصُعِقتْ بهول الموقف، وتوقف قلبها ملتحقة بأمها في حياة أخرى. غادر الأب المنزل غير واعٍ بشيء، ونفد محمد بجلده، مُنظَمًّا إلى قافلة الهجرة، هروبًا من جحيم البقاء في بلده.
[2ــ2ــ2]: المرأة كائنٌ إنسانيٌّ مُعذّب
لم يقف تسريد سياقاتٍ متعلقة بالمرأة، عند بعضٍ من أحوال المرأة اليمنية، بل امتد ليشمل غيرها. ليس فقط في ما يتعلق بيحيى ومصيره الجديد ــ الذي تشكّل بدور الطبيبات الإيطاليات ــ بل في سياقات أخرى، ذات ارتباط مباشر بتفاصيل ارتحاله؛ هربًا من سعير ماضيه وحاضره.
[2ــ2ــ2ــ1]: إطلالة أثيرة
تجلّى أول حضور للمرأة غير اليمنية، في شخصية الطالبة السودانية سارة. زميلة يحيى في دراسته بجامعة صنعاء. تلك الفتاة الهادئة الواثقة من نفسها، التي كان أبوها “معلمًا لمادة اللغة الإنجليزية في إحدى القرى اليمنية، وقد تزوج زميلته السودانية وعاشا معًا دون أن يفكرا بالعودة إلى بلادهما”(27).
هذا هو السياق الوحيد الذي حضرت فيه المرأة غير اليمنية بصورة غير مأساوية، أمّا السياقات الأخرى، فلم تكن فيها المرأة أسعد حظًّا من المرأة اليمنية.
[2ــ2ــ2ــ2]: المرأة وتسريد المأساة الواحدة
من سياقات حضور المرأة غير اليمنية في هذا العمل، المرأة العربية؛ إذ فوجئ يحيى ورفاقه ــ في طريق هجرتهم ــ بمهاجرين عرب، انظموا إليهم. تأملهم، فتعجّب من حال أم وأب، لم تظهر عليهما أيَّةُ مُبالاةٍ، بما هُما مقدمان عليه: “تعجَّبتُ من قدرة الأب على حمل طفله في هذا المصير، من قوة الأم التي تنتظر الجحيم وعلى يدها طفلة جميلة لم تقف على قدميها بعد، كيف بإمكانهما فعل ذلك؟”(28).
ومن ذلك ــ أيضًا ــ ما تضمّنته الإشارة إلى أن جمعًا كبيرًا من النساء ــ المنتميات إلى جنسيات مختلفة لا سيما الأفريقية منها ـــ قد انضم إلى موكب الهجرة. وفي سياق ذلك، يظهر تسريد مأساة المرأة المهاجرة، في الإشارة إلى انسحاق كرامتها، على يد العاملين على تسيير تلك الهجرة المشؤومة: “في كل ليلة تؤخذ النساء إلى غرف مجاورة ويعدن منها ناكسات الرؤوس”(29).
لقد أفضت الصراعات في كل بلد من بلدان هؤلاء، إلى رغبتهم الجماعية في البحث عن حياةٍ أخرى، فلم يكن أمامهم سوى الرضوخ لقَدَرِهم في طريقهم إلى المجهول. بما في ذلك، سيطرة الأمهات على مشاعر أمومتهنّ، مجازفاتٍ بأطفالهن في هذا المسار غير الآمن. يشير يحيى إلى ذلك، بالقول: “شعرت بالرهبة وأنا بين هذه المجموعة وحولنا أطفال تصدح أصواتهم ويتصاعد بكاؤهم وتتأملنا أعينهم بفزع، ودون قلق تقودهم الأمهات إلى البحر، بينما يقف القدر مشمِّرًا عن ساعديه في مكان قصي نجهله تمامًا”(30).
ينطلق قارب المأساة بمن فيه ــ رجالًا ونساءً ــ مع تمايُزٍ في موضع كلٍّ منهما: “النساء في مقدمة القارب ومعهن أطفالهن ونحن في المؤخرة”(31). وعلى ما في هذا التموضع من إحالة على نوعٍ من الرفق المؤوّل بهن، إلّا أن الأمر لم يستقر على ذلك، بل تحول مكانهن ــ ذاك ــ إلى مصيرٍ مأساويٍّ، حُصِرْنَ فيه، حتى تفحّمت أجسادهن بالنار التي اشتعلت بهم. يروي يحيى هول الموقف قائلًا: “فَقَدَ القارب توازنه وبدأ يشتعل، ألسنة اللهب تصاعدت وتوسّعت، الصيحات خرجت من أحشاء الجميع، رأيتهم يتقافزون وعلى أجسادهم النار، جحيم مستعر يأكل الجميع، النساء لم تقدر على الخروج من القارب، رأيت كثيرًا منهن يحترقن، منهن من رمت طفلها للبحر”(32).
[2ــ3]: اتِّساقُ الحضور والبُعد الإنسانيّ
لقد كان حضور المرأة في رواية “عمى الذاكرة” مُتَّسقًا مع ما تستدعيه السياقات السردية من إضفاء الحيوية والانسياب والترابط بين أحداثها؛ إذ امتد تسريد مواقف مرتبطة بالمرأة من بداية العمل حتى نهايته. ولم يكن ذاك الامتداد امتدادًا مهيمنًا على المتن السردي، بل امتدادًا متوائمًا مع كل مساحة سردية وردت فيها المرأة.
كما كانت المرأة اليمنية ذات حضور حيوي وجوهري في هذا العمل. وعلى ذلك، فقد انبثق من تسريد أحوالها بُعدٌ إنساني، امتدت به الرؤية السردية؛ لتشمل المرأة المعذبة في كل مكانٍ، من خلال علاقة المرأة اليمنية ــ المنهكة بمعاناة الصراع في وطنها ــ مع غيرها من نساء الأرض، اللواتي جمعتْها بهن مأساة الصراعات الكارثية في بلدانهن.
- حميد الرقيمي، “”عمى الذاكرة”. ط1، منشورات جدل، الكويت، 2024. وصلت هذه الرواية إلى القائمة القصيرة في جائزة كتارا للرواية العربية 2025. ↩︎
- نفسه، ص136. ↩︎
- نفسه، ص127. ↩︎
- نفسه، ص147. ↩︎
- نفسه، ص5. ↩︎
- نفسه، ص28،27. ↩︎
- نفسه، ص27. ↩︎
- نفسه، ص31. ↩︎
- نفسه، ص14. ↩︎
- نفسه، ص38. ↩︎
- نفسه، ص39. ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه، ص41. ↩︎
- نفسه، ص49. ↩︎
- نفسه، ص66. ↩︎
- نفسه، ص77. ↩︎
- نفسه، ص95. ↩︎
- نفسه، ص97. ↩︎
- نفسه، ص104. ↩︎
- نفسه، ص117. ↩︎
- نفسه، ص143. ↩︎
- نفسه، ص172. ↩︎
- نفسه، ص174. ↩︎
- نفسه، ص10. ↩︎
- نفسه، ص136،135–. ↩︎
- نفسه، ص156. ↩︎
- نفسه، ص139. ↩︎
- نفسه، ص171. ↩︎
- نفسه، ص166. ↩︎
- نفسه، ص172. ↩︎
- نفسه،. ↩︎
- نفسه، ص173. ↩︎