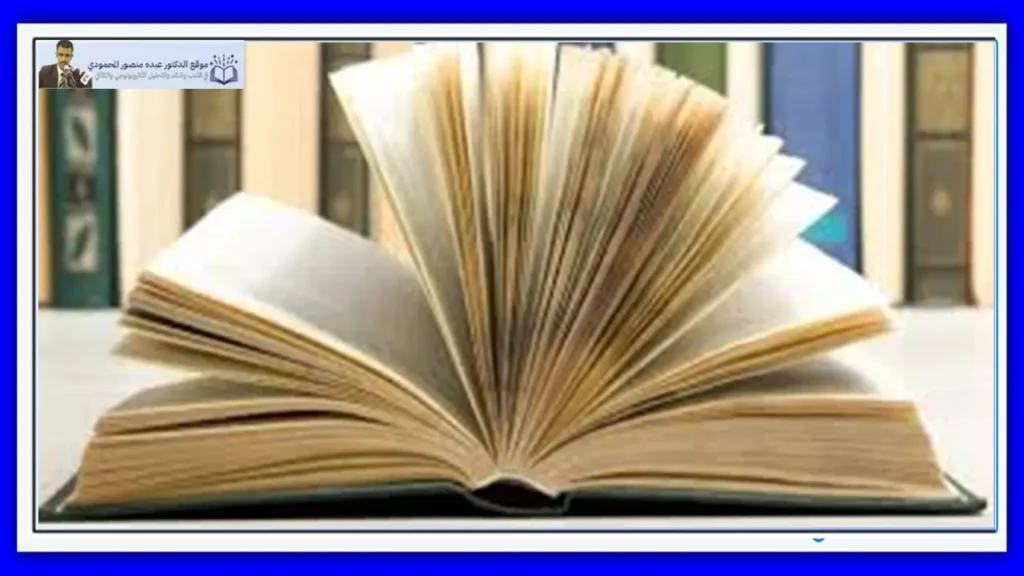مآخذ التوثيق في مقاربات النقد المنهجي
يمثّل محور التعاطي مع هفوات المؤلفين والباحثين، في تعاملهم مع مراجعهم ومصادرهم، واحدًا من مسارات النقد المنهجي، التي كان لها حضور ملموسٌ في اشتغال الأستاذ الدكتور عباس السوسوة على أبحاثه ودراساته. وهو ما سنقف عليه في هذه المساحة، مع التعريج على كتابة السوسوة ــ في أوراق الكتب التي يقرأها وفي هوامشها ــ تعليقاته التي تتضمّن بعضًا من ملاحظات نقده المنهجي.
[1]: رؤىً في التوثيق
[1ــ1]: رصيد معرفي بالمصادر والمراجع
لدى السوسوة معرفة كبيرة بالمصادر والمراجع، فهو قارئٌ نهم وجاد، واقتناء الكتب هوايته المفضلة؛ فلديه مكتبة خاصة كبيرة في منزله. وأهدى “مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة” بتعز، ألفًا وخمسمئةً وتسعة عشر كتابًا(1).
ومما يشد انتباهه عند قراءته بحثًا من البحوث، أو مؤلفًا من المؤلفات، المصادر والمراجع التي اعتمد عليها الباحث في كتابة مادته، والكيفية التي وثقها بها.
ويتضح تركيزه على ذلك، في ملاحظاته على هوامش البحوث وقوائم المصادر فيها، مدققًا في كل ما يتعلق بهذا الأمر. وذلك، هو ما لفت انتباه رئيس تحرير مجلة “جذور”، فطلب منه التخفيف من ذلك، فيكفّ عن ذلك في بعض مواضع كتاباته وملاحظاته على بعض أبحاث هذه المجلة، يشير إلى ذلك بالقول:
“أما الحديث عن الهوامش والمراجع فقد صدني عنها تنبيه تحرير المجلة”(2). أو: “أما الهوامش فغير مطابقة لتعليقاتها، ويصدنا تنبيه التحرير عنها”(3).
[1ــ2]: إحالة على رقم الصفحة والسطر والهامش
في تعليق السوسوة ــ على المصادر والمراجع في الكتب والأبحاث التي يقرأها ــ يحيل على: رقم الصفحة، والسطر، والهامش. وغالبًا ما يوضح ذلك، بالقول:
“سيكون الرقم الأول للصفحة والثاني للسطر مثل (14 ــ 5) أي صفحة 14 سطر5، و (هـ) للهامش. وإذا جاءت فاصلة بعد الرقم الثاني فذلك يعني أن الخطأ تكرر في سطرٍ آخر”(4).
وهذه هي الطريقة، التي يسير عليها في الغالب من تعليقاته على المراجع والمصادر، في أي موضعٍ من مواضع كتاباته النقدية للمصادر والمراجع. ومثال ذلك:
“134ـ هـ 85 تحقيق مهدي المخزومي السامرائيx صوابه: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي”(5).
كذلك، يصوب الأخطاء، التي يقع فيها الباحثون في نقلهم للمعلومة من مصادرها ومراجعها. من ذلك:
“197ف3 وجودة الكتابة. صوابه: الكناية”(6).
[1ــ3]: نسبة المؤلفات إلى غير مؤلفيها الحقيقيين
من مآخذ الدكتور عباس السوسوة ــ على المؤلفين في تعاملهم مع المراجع والمصادر ــ نسبة المؤلفات إلى غير مؤلفيها الحقيقيين؛ اتباعًا لأخطاء شائعة في نسبة تلك المؤلفات. ومن ذلك، أخْذُه على من يرددون أن كتاب “نقد النثر” لقدامة بن جعفر ترديدهم لهذه الفكرة؛ فهذا الكتاب يحمل اسمًا آخر، هو “”البرهان في وجوه البيان” لابن وهب الذي نشر خطأً باسم نقد النثر ونسب إلى قدامة”(7). وهو ما يتفق معه عباس السوسوة. لذلك؛ كان واحدًا من مآخذه على مراجع واحدٍ من البحوث التي تناولها بالعرض والنقد، إذ يقول:
“وجيء بعناوين ثبت زيفها منذ زمن بعيد، ككتاب نقد (النثر) لقدامة بن جعفر، في حين أن صحته: كتاب البيان لابن وهب الكاتب”(8).
ويزيد ذلك إيضاحًا، في مأخذٍ على باحثٍ آخر نسب هذا الكتاب إلى قدامة خطأً، فيوضح أن هذا الكتاب “من تأليف إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب. وحققه أولًا أحمد مطلوب وزوجته خديجة الحديثي عام 1967م في بغداد، ثم حققه المرحوم حفني محمد شرف عام 1969م في القاهرة”(9).
كذلك هو الأمر مع كتاب “شرح ديوان المتنبي”، المنسوب خطأً إلى العكبري. وقد استشهد السوسوة بشاهدٍ شعريٍّ من هذا الكتاب، في كتابه “العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية”، وأشار إلى أنه منسوبٌ خطأً إلى العكبري(10). لذلك؛ كان مأخذًا من مآخذه على بحث “تعدد القراءات في تراثنا الشعري” لنورة الشملان، التي سارت على هذه النسبة الخاطئة للكتاب. ووضّح أنه خطأٌ شائع بين الباحثين، فقال: “وهذا الخطأ لا تنفرد به الباحثة، بل هو شائع عند الكثيرين، مع أن المرحوم مصطفى جواد منذ خمسين سنة قد أثبت من خلال الشرح ووقائع وملابسات أخرى أنه لا يصح أن يكون لأبي البقاء الحسين بن عبد الله العكبري (ت 626هـ)، ورجح أن يكون لعكبري آخر هو ابن عدلان الموصلي”(11).
[1ــ4]: أعمال القرصنة
مما يثير حفيظة الدكتور عباس السوسوة ــ في هذا الجانب من النقد المنهجي ــ أعمال القرصنة على المؤلفات. سواءٌ من الباحثين، الذين ينسبون أعمال الآخرين إليهم، أو من دور النشر، التي تسطو على مطبوعات غيرها.
والسوسوة ــ في حديثه عن القرصنة ــ إمّا أن يشير إلى عملٍ ما، تعرض لقرصنةٍ، من دون أن يذكر الجهة التي قامت بهذه القرصنة. كما في واحدةٍ من ملاحظاته، على كتاب الصوينع “توثيق الترجمة والتعريب”، يقول فيها:
“ص125 ذكر أن رواية (الأرض) لزولا تُرجمت سنة 1966م، أقول: ترجمها د.رفعت السعيد في مجلد كبير، ثم بعد أعوامٍ سطا عليها أحد القراصنة، وقسمها على جزئين ونسبها لنديم مرعشلي”(12).
ففي هذه الملاحظة، لم يذكر الجهة أو الشخص الذي قام بالقرصنة، فالقائم بالقرصنة هنا مجهولٌ غير محدد، وهو بالطبع دار النشر.
وإمّا أن يذكر الجهة التي قامت بالقرصنة. فمثلًا، يصنف دار “عالم الكتب” في بيروت دارَ قرصنة؛ إذ يقول في تعليقه على بحث “إسهام اللغويين الأوائل في الدراسات الصوتية”، لمحمد حسن باكلا:
“أورد أن المقتضب للمبرد نشر عالم الكتب ببيروت، د.ت، والصواب أنه نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة 1979 (ط2). أما المذكورة فمن دور القرصنة”(13).
كذلك يرى أن “دار الكتب العلمية” في بيروت و”المكتبة التوفيقية” في القاهرة، يقومان بسرقة جهود المحققين، فيقول في واحدٍ من مآخذه على أحد المؤلفات:
“ذكر أن (الدرر اللوامع) لأحمد بن الأمين الشنقيطي حققها عبد العال سالم في الكويت، وهذا حق، ثم أردف (حققه وشرح شواهده أحمد السيد سيد أحمد علي، القاهرة: المكتبة التوفيقية…
قلت: هذه التوفيقية صارت في السنوات الأخيرة تقوم بعمل دار الكتب العلمية ببيروت من سرقة جهود المحققين أو الإغارة عليهم”(14).
وقد أكسبته معرفته الواسعة بالمراجع والمصادر، هذه النظرة الدقيقة في مصادر ومراجع ما يقرأ من البحوث والمؤلفات، وفحْص الآلية التي تعامل بها هؤلاء الباحثون مع معلومات مصادرهم، وتوثيقها من الطبعات السليمة غير طبعات القراصنة.
[2]: النقد المنهجي تعليقات في صفحات ما يقرأ
يبدو أن النواة الأولى لنقد السوسوة المنهجي، تبدأ بملاحظاته وتعليقاته على ما يقرأ، فهو في قراءته ــ كما يقول ــ يقرأ والقلم بيده، فيعلق كلما رأى ما يقتضي التعليق، ومن مجموع هذه التعليقات على البحث أو الكتاب الذي يقرأه، يُكَوِّنُ نقدَه لهذا الكتاب أو البحث.
ومن الواضح أنه كل ما تقع عليه يده ويقرأه، يكون لتعليقات قلمه مكانٌ في صفحاته. وهذا ما يجده القارئ أو المتصفح للكتب والبحوث والدوريات التي قرأها السوسوة، سواءٌ في مكتبة السوسوة الخاصة، أو في الكتب التي أهداها إلى “مكتبة السعيد العامة” التابعة لـ”مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة” بتعز.
[2ــ1]: تعليل وتصويب المراجع والمصادر
من تعليقات قلم السوسوة ، ما همَّش به صفحات كتاب “الدراسات اللغوية والنحوية في مصر منذ نشأتها حتى نهاية القرن الرابع الهجري” لمؤلفه الدكتور أحمد نُصَيِّف الجنابي. ففي الصفحة التي يعترض فيها على قول أحمد مختار عمر، أن مصر غصت باللغويين والنحاة في مطلع القرن الثالث الهجري؛ بحجة أنه لم يذكر عددًا كافيًا من أسماء اللغويين والنحاة في مصر؛ حتى يؤكد قوله هذا(15). يعلق السوسوة ــ على هذا الاعتراض ــ بالقلم الأحمر، في الصفحة نفسها، بقوله:
“قال عباس: سبب ذلك بسيط، وهو أنه ليس من اللازم أن يأتي بقائمة لكل اللغويين، فالتمثيل فيه الكفاية”(16).
ومن أبرز ما يعلق به على ما يقرأ، تعليقاته على مصادر المؤلفين والباحثين، إذ يستدرك أخطاء، في أسماء المؤلفات وطبعاتها وتواريخ طبعها، وما إلى ذلك، مما يتعلق بمعلومات النشر والطباعة والتوثيق.
ومن ذلك، هذا التصحيح الوارد ضمن تعليقات السوسوة، على مصادر كتاب “علم اللغة المقارن” للدكتور حازم علي كمال الدين؛ إذ وثق المؤلف المصدر الرابع والستين، من مصادر الكتاب، في قائمة المصادر والمراجع، بقوله:
“64 ــ المزهر فــي علـــــوم اللغة للسيوطـي شـرحه وضبطه وصـــــححه محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العربية ــ عيسى البابي الحلبي وشركاه ــ القاهرة (بدون تاريخ)”(17).
فيشطب السوسوة هذه العبارة المقوسة: (بدون تاريخ). ثم يصحح ذلك، بإضافة تاريخ نشر هذا الكتاب؛ “1958”(18).
[2ــ2]: “إحم .. إحم!”
في بعض تعليقات السوسوة ــ هذه ــ يكتفي بوضع إشارةٍ فقط. كأن يكون التعليق علامة استفهام، أو تعجب، أو التركيب (احم احم)، …
ومن ذلك، تعليقه على واحدةٍ من مقومات طريقة الدراسة اللغوية المقارنة، التي أوردها الدكتور حازم علي كمال الدين، في كتابه “علم اللغة المقارن”؛ إذ أورد ثالث هذه المقومات، في قوله:
“يجب الإلمام بكل صغيرة وكبيرة ترتبط بالظاهرة في كل لغة من حالة الدراسة المقارنة”(19).
فيضع السوسوة خطًا تحت عبارة “يجب الإلمام بكل صغيرة وكبيرة”(20). ثم يظهر تعليقه على ذلك، في منتصف الهامش الأيمن للصفحة نفسها، بهذا التركيب: (احم احم)(21)، مكتفيًا بهذه الإشارة، التي تعبر عن عدم الموافقة على ما يذهب إليه المؤلف. من دون تفصيلٍ لأسباب عدم الموافقة. وقد تكون هذه الإشارة شفرةً تذكره بوجه اعتراضه عند تناوله النقدي التفصيلي للكتاب أو البحث الذي تأتي في صفحاته مثل هذه الإشارات.
[3]: عن منهجية كتابه “العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية”
على كثرة مآخذ السوسوة المنهجية على المؤلفين والباحثين، إلّا أنه لم يسلم هو من مثل هذه المآخذ؛ إذ وجد الدكتور قحطان رشيد صالح، عليه مأخذًا منهجيًا في عرضه لكتاب “العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية”. وقد تمثل هذا المأخذ، في خلو منهج تأليف الكتاب من مقدمةٍ، تتضمن ما تتضمنه مقدمات المؤلفات من حديثٍ عن منهجية تأليف الكتاب؛ إذ يقول ــ الدكتور قحطان ــ في عرضه للفصل الثاني من الكتاب:
“ويُلاحظ أن الكثير مما ضمه هذا الفصل، كان يحسن أن يكون مكانه المقدمة، التي خلا منها منهج التأليف”(22).
وعلى أن السوسوة قد ذكر في هذا الفصل أن فكرة الكتاب بدأت في 1985م ــ حينما كان طالبًا في مرحلة الدكتوراه(23)، وذكر أن منهج الكتاب منهج تاريخي، بحيث يؤرخ للظواهر اللغوية ملتزمًا بدائرة المؤرخ اللغوي، الذي يجب أن تكون دراسته دراسة علمية موضوعية محايدة، وذكر طريقة توثيقه للمراجع والمصادر(24) ــ إلّا أن مثل هذه الأمور التي ذكرها في هذا الفصل، يستحسن في رأي الدكتور قحطان أن يكون مكانها المقدمة؛ إذ يقول:
“فهذا الذي تقدم وغيره، لو ضم الأخ الباحث بعضه إلى بعض لكانت مادةً تثري التقديم، وتوضح مبلغ اهتمام المؤلف بمثل هذه الموضوعات منذ ما يزيد على خمسة عشر عامًا، وأنها ثمرة تتبع وتنقير واستقراء ووصف جعل الكتاب زادًا لغويًّا لا يستغني عن تذوق حلاوته المعنيون من ذوي الاختصاص وغيرهم”(25).
وإن كان السوسوة قد تحدث عمّا تتضمنه المقدمات في هذا الفصل، إلا أن الأحرى في ذلك ضمه إلى مقدمةٍ، تمثل عتبة الدخول الأولى للقارئ. وهو ما ذهب إليه الدكتور قحطان رشيد؛ إذ إن الأدبيات التي تتناول البحث العلمي، تكاد تجمع على أن البوابة الأولى لأية دراسةٍ علمية هي المقدمة؛ فمن خلال المقدمة يتعرف القارئ على موضوع الدراسة وأهميتها والمنهجية التي سارت عليها، فيقرر بعد قراءتها قراءة الدراسة أو عدم القراءة.
- “لوحة الشرف” في رواق “مؤسسة السعيد للثقافة والعلوم”، بتعز. ↩︎
- عباس علي السوسوة، “في النحو التاريخي للفصحى، وملاحظات”. مجلة جذور، النادي الأدبي الثقافي بجدة، العدد (10)، المجلد (6)، رجب 1423هـ ــ سبتمبر 2002م، ص: (104). ↩︎
- نفسه، ص: (106). ↩︎
- عباس علي السوسوة، “ملاحظات مفتش نظافة سويسري”. مجلة جذور، النادي الأدبي الثقافي بجدة، العدد (6)، مجلد(3)، رجب 1422هـ ـ سبتمبر 2001م، ص: (508). ↩︎
- نفسه، ص: (511). ↩︎
- عباس علي السوسوة، “أزاهير وأشواك وكهرمان” مجلة جذور، إصدارات النادي الأدبي الثقافي بجدة، العدد (21)، المجلد (9)، رجب 1426هـ ـ سبتمبر 2005م، ص: (126). ↩︎
- شوقي ضيف، “البحث الأدبي: طبيعته، مناهجه، أصوله، مصادره”. ط8، دار المعارف، القاهرة، د.ت، ص: (80). والكتاب من منشورات دار الكتب العلمية، د.ط، بيروت، 1402هـ ــ 1982م. ↩︎
- عباس السوسوة، “تطبيقات عربية على نحو النص، كتاب مؤتمر: (العربية بين نحو الجملة ونحو النص)”. كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، في الفترة: (22ـ 23) فبراير 2005م، ص: (623). ↩︎
- عباس علي السوسوة، “اللغة العربية: تأليف: كيس فرستيغ، ترجمة: محمد الشرقاوي”. عرض ونقد. مجلة الدراسات اللغوية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، العدد (3)، المجلد (9)، رجب ـ رمضان 1428هـ ــ يولية ـ سبتمبر 2007م، ص: (215). ↩︎
- عباس علي السوسوة، “العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية”: دار غريب، القاهرة، 2002م، الهامش: ص: (162)، هامش: (150). ومن طبعات الكتاب، الطبعة التي ضبطها وصححها ووضع فهارسها: مصطفى السقا، وإبراهيم الإبياري، وعبدالحفيظ شلبي. دار المعرفة، د.ط، بيروت، د.ت. ↩︎
- عباس علي السوسوة، “لساني فضولي يتطفل على قراءة النص”. مجلة علامات، النادي الأدبي الثقافي بجدة، العدد (49)، مجلد (13)، رجب 1424هـ ـ سبتمبر 2003م، ص: (337). ↩︎
- عباس علي السوسوة، “ملاحظات على كتاب الصوينع (توثيق الترجمة والتعريب)”. مجلة علامات، إصدارات النادي الأدبي الثقافي بجدة، العدد (57)، المجلد (15)، رجب 1427هـ ـ سبتمبر 2005م، ص: (103). ↩︎
- عباس علي السوسوة، “عن حاملي عصا التصويب اللغوي، ومتفرقات”. مجلة جذور، النادي الأدبي الثقافي بجدة، العدد (9)، مجلد (5)، ربيع الآخر 1423هـ ـ يونيو 2002م، ص: (85،84). ↩︎
- عباس علي السوسوة، “معجم المؤلفين المعاصرين في آثارهم المخطوطة والمفقودة وما طُبع منها أو حقق بعد وفاتهم”. عرض ونقد: مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، العدد (1)، مجلد (12)، المحرم ـ جمادى الآخرة 1428هـ / يناير ـ يوليو 2007م، ص: (382). ↩︎
- أحمد نصيف الجنابي، “الدراسات اللغوية والنحوية في مصر منذ نشأتها حتى نهاية القرن الرابع الهجري”. مكتبة دار التراث، القاهرة، 1397هـ ــ 1977م، ص: (201). النسخة المُهداة إلى “مكتبة السعيد العامة”، التابعة لـ”مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة”، تعز، برقم: [ جن ـ د/ 96,410]. ↩︎
- نفسه. ↩︎
- حازم علي كمال الدين، “علم اللغة المقارن”. مكتبة الآداب، القاهرة، 1420هـ ــ 1999م، ص: (229). النسخة الموجودة في مكتبة عباس السوسوة الخاصة. ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه، ص: (72). ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه. ↩︎
- قحطان رشيد صالح، “قراءة وعرض في التواصل اللغوي”. صحيفة الثقافية، تعز، العدد ( 147)، 9 ربيع ثاني 1423هـ ــ 20 يونيو 2002م، ص: (20). ↩︎
- عباس علي السوسوة، “العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية”. مرجع سابق، ص: (24). ↩︎
- نفسه، ص: (27،26). ↩︎
- قحطان رشيد صالح، “قراءة وعرض في التواصل اللغوي”. مرجع سابق، ص: (20). ↩︎