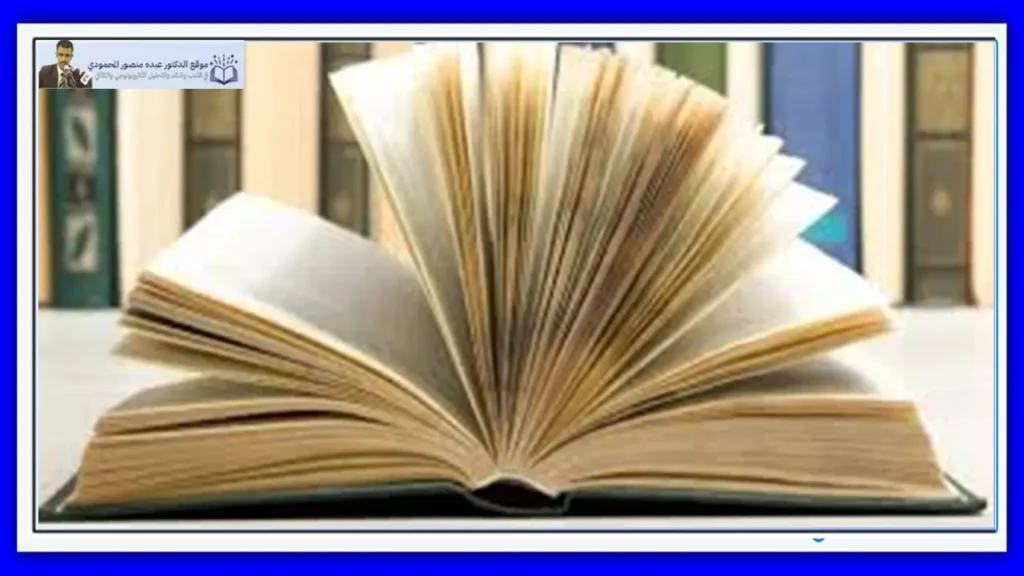النقد الأدبي في سياق الدرس اللساني الحديث
النقد الأدبي، “شكلٌ من أشكال المعرفة العلمية، هدفه إضاءة وتفسير شروط إنتاج الآثار الأدبية”(1). كما أنه “نشاطٌ إنساني يستخدم اللغة أداة لا ليعبر عن موقفٍ جمالي كما هو حال الأدب، بل ليكتب عن الأدب”(2).
ومجال هذا النشاط الإنساني، هو الإبداعات الأدبية. إذ يهدف إلى تفسير وتحليل الآثار الأدبية؛ وفقًا لنظريات النقد الأدبي المتداولة. تلك النظريات، التي تتناول النص الأدبي، من زوايا مختلفة؛ استنادًا إلى الرؤى الفكرية، التي تفلسف مسارات واتجاهات كل نظرية.
وقد وردت في أثناء أبحاث الدكتور عباس السوسوة وكتاباته، إشاراتٌ متسمة بسمات وإجراءات النقد الأدبي تارة، ونقد النقد الأدبي تارة أخرى. إذ جاءت مثل هذه الإشارات بصفةٍ عرضية في كتاباته وأبحاثه اللسانية. فهو لا يطرق هذا الباب، إلا ما جاء منه في صورة إشاراتٍ وملاحظاتٍ عرضية وعابرة(3).
[1]: نقد أدبي
للسوسوة ملاحظات في النقد الأدبي، منها ما يتناول الأدب القديم، ومنها ما يتناول الأدب العربي الحديث. كما أن منها ما جاء إشارات نقدية عامة. أو إشارات نقدية روائية. أو إشارات ضمّنها نقدًا أدبيًّا ذاتيًّا، لتجربته في الكتابة الأدبية، القصصية والشعرية.
[1ــ1]: نقد الشعر العربي القديم
من ملاحظات السوسوة النقدية، التي تناولت الشعر العربي القديم، تلك الملاحظة التي تضمنت واحدًا من تعليقاته، على مقالٍ، يقول صاحبه فيه إن (لزوميات) المعري، انتقالٌ للمعري من مرحلة الاتباع والتقليد، التي كانت في (سقط الزند)(4). ويبدي السوسوة رأيهُ النقدي مبنيًا على تذوق المتلقي، فيرى أن (سقط الزند) هو المتضمن للشعر الحقيقي لا اللزوميات. يقول في تعليقه على ذلك:
“ونحن نرى أن هذه مسألة ذوقية. فإذا كان المراد بالشعر الذي يهز المشاعر، ويبعث في نفس المتلقي النشوة، فإن سقط الزند هو المتضمن للشعر الحقيقي لا اللزوميات”(5).
[1ــ2]: نقد الشعر العربي الحديث
من إشارات السوسوة النقدية، التي تناول فيها شعرًا حديثًا، جاء من ملاحظاتٍ نقدية في تشريحه، لما أسماه بـ “أسطورة نخوة المعتصم”. إذ يقول إن هذه الأسطورة قد صارت واحدة من الأساطير في ثقافتنا العربية. وبذلك؛ كان لها تجلياتٌ كثيرة في الشعر العربي المعاصر. يذكر منها أبياتًا من معارضة الشاعر عبد الله البردوني، لبائية أبي تمام في قصيدته “أبو تمام وعروبة اليوم”(6):
ما أصدق السيف إن لم ينضه الكذبُ ** وأكذب السيف إن لم يصدق الغضبُ
بيضُ الصفائحِ أهدى حين تحملها ** أيدٍ إذا غلبت يعــــــــلو بـها الغَلَبُ
أدهى من الجهل علمٌ يطمئن إلى ** أنصافِ ناسٍ طغوا بالعلمِ واغتصبوا
ماذا فعلنا؟ غضبنا كالرجال ولم ** نصـدقْ، وقد صدقَ التنجيمُ والكتبُ
ويرى أن فضل الصياغة النهائية لهذه الأسطورة، “يعود إلى عمر أبو ريشة (ت1991م)، في قصيدته التي أنشأها عام 1949م بعنوان: أمتي، ثم غير عنوانها إلى (بعد النكبة)، ثم إلى (نخوة المعتصم)، ومطلعها(7):
أمتي هل لكِ بين الاممِ ** منبرٌ للسيفِ أو للقلمِ
[1ــ3]: إشارات نقدية عامة
من الإشارات النقدية، التي وردت في سياق بعض من أبحاثه وكتاباته، ما يتعلق منها بملاحظاته النقدية الساخرة، على القصائد المنشورة في الصحف والمجلات، من دون اختيارٍ حصيف من الناشرين. وهو ما يجعل من هذه القصائد ــ من وجهة نظره ــ أعجوبة فاتت البرنامج التلفزيوني “عالم عجيب”(8). ذلك؛ لأن في هذه القصائد “غثاء يغم النفوس والمشاعر. وينحط بالأذواق، ويصيب القراء بصداعٍ مزمن”(9). إذ لا فرق في ذلك، بين قصائد عمودية وغير عمودية، فالعمودية “لم يعد فيها غير الشكل الخارجي. فكثيرًا ما ترى الشعرور يخلط بين الأبحر، بل يأتي بأبيات لا تنتمي لأي بحر… وفوق هذا تجد المعاني إن كان فيها معاني هزيلة أو منحطة”(10).
أما القصائد غير العمودية “فلها أسماء تفوق أسماء القط ولها شنة ورنة، وسوقها بين المتشاعرين وأدعياء النقد هي الأروج. وأجودها ــ هذه الأيام ــ تقرأ مرة واحدة ثم ترمى كالإبر الميدانية”(11).
ثم يردف ملاحظاته النقدية بعيناتٍ ممثلة لهذه القصائد، منها(12):
1 ـ أخرج من بؤبؤ عيني
حاملًا رحم أمي على كتفي
2 ـ أشرب البن الممزوج بلبن الشهوة.
وتشمل ملاحظاته النقدية الساخرة ــ هنا ــ كلا الفريقين: شعراء العمود، الذين يصفهم بالشعارير، والمفرد من ذلك (شعرور). والشعرور، في النقد الأدبي القديم عند العرب، آخر الشعراء مرتبة، فهو رابعهم؛ و”الشعراء عندهم أربع طبقات، فأوّلهم: الفحل الخنديذ، والخنذيذ هو التامّ، قال الأصمعي: قال رؤبة: هم الفُحولة الرواة، ودون الفحل الخِنذيذِ: الشَّاعرُ المُفْلِقُ، ودونَ ذلك الشاعرُ فقط، والرَّابع الشُّعْرُور”(13).
وكذلك هم شعراء القصائد غير العمودية، التي تمثل مدرسة شعرية حديثة. إذ يسخر من كثرة أسمائها: حرة، وتفعيلة، وقصيدة نثر…
وفي مقالٍ آخر من مقالاته، وردت مثل هذه الملاحظات النقدية العامة على النتاج الأدبي، المنشور في الصحف والمجلات، واصفًا إياه بـ”الغثاء”، فيقول إن هذا الغثاء ينشر “في صحفنا ومجلاتنا تحت عنوان (قصة) أو (قصيدة)”(14).
[1ــ4ــ1]: نقد روائي
للسوسوة ملاحظات نقدية في الجانب الروائي، على رواية “أمري كانلي أمري كان لي”، للروائي صنع الله إبراهيم. يتناول فيها الكيفية، التي استطاع من خلالها الروائي تمرير أيديولوجيته في الرواية، بطريقة فنية غير منفرة للقارئ. ومفهوم الأيديولوجيا، أنها “نظام فكري، أو نسق من الأفكار، التي تعتنقها مجموعة من البشر، وتحدد رؤية العالم أو تفسير ظواهره …”(15).
ويستهل السوسوة حديثه عن ذلك، بأنه ليس هناك عملًا سرديًّا، إلا ويحمل في ثناياه أيديولوجيا. فإذا كان الكاتب موهوبًا وخبيرًا استطاع أن يمرر أيديولوجيته في العمل، من دون أن ينفر القارئ منه. عكس الكاتب نصف الموهوب، الذي سرعان ما ينفر القارئ من إبداعه(16).
ويهدف من وراء حديثه عن الأيديولوجية في هذه الرواية، إلى الكشف عن أيديولوجية هذا الروائي. و”كيف عرض أيديولوجيته بصيغتي الإفراد والجمع في إطار أو نسيجٍ سردي محكم، مقدمًا للقارئ رواية فنية متميزة”(17).
وقد استلهم عنوان مقالته “رائحة الأيديولوجيا في رواية “أمري كان لي” “أمري كانلي”(18) ــ كما يقول ــ من عنوان إبداعي آخر للروائي نفسه. هو: “تلك الرائحة”(19).
[1ــ4ــ2]: ملامح أيديولوجية الكاتب صنع الله إبراهيم
بعد ملاحظات السوسوة على روايات الكاتب، وعلى عنوان الرواية وهيكلها، وبعد أن يستعرض فصولها، يستخلص ملامح أيديولوجية الكاتب، مجملًا إيّاها في المحاور الأربعة التالية:
- الهجوم على السياسة الأمريكية حاليًا وفي القرن العشرين وما قبله بقرنين ــ أيضًا ــ وتسلطها على جيرانها في أمريكا الوسطى والجنوبية وشرق آسيا، ثم في الشرق الأوسط.
- النقل عن كُتاب يساريين وغير يساريين أحيانًا، يوافقون هواه …
- الهجوم على فترة حكم الرئيس (أنور السادات) …
- التكهرب من كل شيءٍ وصفه “إسلامي”، سواء كان هذا الموصوف إسلاميًّا حقيقة أم لا.
هذه هي المحاور الرئيسة، التي تَجَسد من خلالها تمريرُ الكاتب لأيديولوجيته. ولم يحدد السوسوة هذه الأيديولوجية. لكن الواضح ــ من خلال المحاور التي استخلصها ــ أنها تميل إلى توجهٍ يساريٍّ، فيقول عن الروائي إنه “روائي تقدمي ملتزم بالتقدمية ويراجع نفسه إزاءها من عمل إلى آخر، لكن تبقى ثوابت أيديولوجية، لا يغيرها أبدًا”(20).
وهذه الثوابت الأيديولوجية، انطلقت من هذه المحاور الأربعة، ممتدةَ الخيوط في الرواية. باحترافٍ فني، تمثّل في توظيف الهوامش، وتوظيف حجم الخط فيها بتعدد أحجام الخط من فكرةٍ إلى أخرى(21). فقد كان الهامش ــ كما يقول صنع الله إبراهيم ــ استكمالًا لما يأتي في متن الرواية، من تفاصيل صغيرة. كتفاصيل قصة (مونيكا)، التي تلقي الضوء على الحياة الأمريكية وقيمها الأخلاقية وصراعاتها السياسية(22).
جاء تمرير هذه الخيوط الأيديولوجية، باحترافٍ فكريٍّ، تمثّل في القدرة على إيجاد واختيار المواطن المناسبة، لتمرير خيوط هذه الأيديولوجية بما لا يبتر نسيج الفكر السردي، ولا يحدث تشوهًا في البناء العام للرواية.
[1ــ5]: النقد الأدبي الذاتي
من تجليات النقد الأدبي في تجربة السوسوة، نقده الأدبي الذاتي لإبداعه القصصي والشعري. و”نقد الذات هو مراجعتها بدون تأن أو تحرج”(23). وقد راجع ذاته في إبداعه القصصي، فوجد أن الأولى ترك هذا النوع من الكتابة، إذ يقول عن ذلك: “كنت أيام طيش الشباب أكتب القصة القصيرة، وبعد وقفة جادة مع النفس وجدت أني لم أكن مميزًا فيها، وأن جماهير القراء لا ينقصها الغم، فتركتها”(24).
ويعلق على معارضاته الشعرية، بأنها “ليست معارضات بقدر ما هي محاكاة هزلية للتسلية، وتجربة النظم للتمرن على استخدام العروض”(25).
[2]: نقد النقد الأدبي
دراسة النقد الأدبي، وتحليل الرؤى الناقدة للإبداعات الأدبية، لا يزال حقلًا خصبًا وبكرًا في النقد الأدبي عند العرب. يقول الدكتور عبد الملك مرتاض، عن ذلك: “وأما تحليل النقد المكتوب في إطارٍ نقدي ــ منهجي، موضوعي ــ أي في إطار ما يطلق عليه، في العهد الراهن، في المصطلحات النقدية الجديدة: نقد النقد فذلك ما لما نرس له تقاليده في مسار الفكر النقدي المعاصر”(26).
وقد تناول السوسوة في مواضع من كتاباته رؤىً نقدية، فوقف عندها، مفندًا ما فيها من بعدٍ عن موضوعية الفكر، وواقعية المعرفة.
[2ــ1]: زمن نظم قصيدة حسّان بن ثابت “عفتْ ذاتُ الأصابع فالجواءُ”
من رؤى السوسوة ذات الانتماء إلى “نقد النقد”، ما جاء في واحدٍ من تعقيباته على كتاب “المدائح النبوية” لمحمود علي مكي. إذ وقف عند قول المؤلف: “إن قصيدة حسان بن ثابت “عفتْ ذاتُ الأصابعِ فالجواءُ” منظومة قبل فتح مكة وبعدها”(27). فيعقب على هذه الرؤية، ويفندها، بقوله: “فيما ذهب إليه نظر، لأن بردة كعب بن زهير “بانت سعاد” فيها غزل حسي ليس بالقليل. وفيها وصف لأسنان المحبوبة “كأنهُ مَنْهلٌ بالراحِ مَعْلولُ” فقصيدة حسان لا تخرج عن هذا التقليد الفني”(28).
[2ــ2]: تقليد لزوميات أبي العلاء المعري
من ملاحظات السوسوة ــ في هذا الجانب ــ تفنيده لأحكامٍ خاطئة، وردت في مقال بلال عبدالفتاح: “ما شذ عن اللزوميات، المعري رائيًا”. ومن تلك الأحكام، الحكم بأن “المعري لم يقلده أحد في التزام ما لا يلزم”(29). ويفند السوسوة هذا الحكم، بالقول:
“نحن نزعم أن الشاعر اليمني أحمد بن محمد الشامي نشر في أول الثمانينيات “لزوميات الشعر الجديد” وهو يقلده في التزام ما لا يلزم، وإن لم يكن الديوان كبيرًا”(30).
[2ــ3]: “أيّام” طه حسين
من ذلك، ــ أيضًا ــ ملاحظات السوسوة على بحث سلطان سعد القحطاني “قراءة النص النقدي عند الرواد”. ومنها، ملاحظته على قول الباحث: “إن (الأيام)(31) أول سيرةٍ ذاتية عربية (…) فلم يعرف الأدب العربي قبلها فن السيرة (ذاتية وغيرية) خاصة ما يتعلق منها بحياة الكاتب نفسه”(32).
لكن السوسوة يرى أن هذه السيرة (الأيام) ليست الأولى، فيذكر “مؤلفات يتحدث فيها المؤلف عن نفسه، في مرحلة من حياته أو أكثر كالمنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي، والاعتبار لأسامة بن مرشد بن منقذ”(33). وبذلك؛ يصل إلى “أن الأيام ليست الأولى”(34).
[2ــ4]: عن كتاب البردوني “من أول قصيدة إلى آخر طلقة”
من ملاحظات السوسوة في نقد النقد الأدبي، ما وجده من مآخذ على كتاب عبد الله البردوني: “من أول قصيدة إلى آخر طلقة، دراسة في شعر الزبيري”. إذ وجد فيه مآخذ: علمية، ولغوية، وطباعية.
وقد أورد نماذج لذلك(35). كما علل وقوع البردوني في مثل تلك الأخطاء، باعتماده على ذاكرته وحدها من دون العودة إلى مصادر ومراجع مادة الكتاب. إذ يقول إن سبب ذلك “أن المؤلف اعتمد في ذكر المعلومات والتواريخ والقضايا ــ وما أكثرها ــ وكذلك في ذكر أسماء الأعلام ورواية الشعر والنثر على ذاكرته دون أن يستند عمل الذاكرة بالرجوع إلى المصادر والمراجع المعتمدة”(36). فقد كان اعتماد الذاكرة وحدها، وحفظ النصوص سببًا في الوقوع في مثل تلك المآخذ. كما كان أحد أسباب عدم تبلور موقفه النقدي، في كتابه “رحلة في الشعر اليمني قديمة وحديثه”(37).
وفي الحقيقة أن اكتفاء البردوني بذاكرته ومحفوظاته، عائدٌ إلى عدم قدرته على العودة إلى المصادر والمراجع متى شاء. ذلك؛ لحرمانه من نعمة البصر، “فالبردوني لا يقرأ متى يشاء ولا يكتب متى يشاء، وإنما يعتمد على مخزونه من قراءات غيره، التي تلعب فيها الذاكرة دورًا كبيرًا. لكنه يحتفظ بالفكرة ولا يستطيع الاحتفاظ بالنصوص والصفحات والمراجع”(38).
لقد جاء نقد النقد الأدبي ــ عند السوسوة ــ عرضًا، وبصفةٍ ثانوية، كما هي الحال مع نقده الأدبي. لذلك؛ ورد في مواضع مختلفة من أبحاثه. لاسيما تلك، التي تناول فيها أبحاثًا ومقالاتٍ منشورة في مجلتي: “علامات في النقد”، و”جذور التراث”، الصادرتين عن “النادي الأدبي الثقافي بجدة”(39).
- سمير سعيد حجازي، “قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، عربي، إنجليزي، فرنسي”. ط1، دار الآفاق العربية، القاهرة، 1421هـ ــ 2001م، ص:(33). ↩︎
- ممدوح أبو الوي، “النقد الأدبي رؤى وأفكار”. مجلة علامات، إصدارات النادي الأدبي الثقافي بجدة، العدد (58)، المجلد (11)، ذو القعدة 1426هـ ــ ديسمبر 2005م، ص: (289،288). ↩︎
- من المقابلة التي أجراها معه الكاتب. في مدينة تعز، يوم الأربعاء: 16 جمادى الأولى 1429هـ ــ 21 مايو 2008م. ↩︎
- عباس علي السوسوة، “ملاحظات مفتش نظافة سويسري”. مجلة جذور، النادي الأدبي الثقافي بجدة، العدد (6)، مجلد(3)، رجب 1422هـ ــ سبتمبر 2001م، ص: (527). ↩︎
- نفسه. ↩︎
- عباس علي السوسوة، “تشريح أسطورة نخوة المعتصم”. مجلة جذور، إصدارات النادي الثقافي الأدبي بجدة، العدد (23)، المجلد (10)، صفر 1427هـ ــ مارس 2006م، ص: (168). وانظر: عبد الله البردوني، “الأعمال الشعرية الكاملة”. إصدارات الهيئة العامة للكتاب، صنعاء، 2004م، المجلد (1)، ص: (625،624). ↩︎
- نفسه، ص: (167). وانظر: جميل علوش، “عمر أبو ريشة حياته وشعره مع نصوص مختارة”. دار الرواد، بيروت، 1994م، ص: (16،15). ↩︎
- عباس علي السوسوة، “بدون جمارك، عالم عجيب، فكسميلي الشعر”. صحيفة البلاغ، صنعاء، العدد (5)، 2رجب 1411هـ ــ 17يناير 1991م، ص: (7). ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه. ↩︎
- الجاحظ، “البيان والتبيين”. تحقيق: حسن السندوبي. ط1، دار إحياء العلوم، بيروت، 1414هـ ــ 1993م، المجلد الأول، جـ2/ ص: (385). ↩︎
- عباس علي السوسوة، “فشر يفشرُ”. صحيفة البلاغ، صنعاء، العدد (1)، 25 ربيع الثاني 1411هـ ــ 13نوفمبر 1990م، ص: (6). ↩︎
- محمد عناني، “المصطلحات الأدبية الحديثة، دراسة ومعجم إنجليزي ــ عربي”. ط1، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، القاهرة، 1996م، ص: (43،42). ↩︎
- عباس السوسوة، “رائحة الأيديولوجيا في رواية “أمريكانلي” “أمري كان لي” لـ “صنع الله إبراهيم””. صحيفة الثورة، الملحق الثقافي، صنعاء، العدد (14936)، 29 شعبان 1426هـ ــ 3 أكتوبر2005م، ص: (5). ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه. وانظر: صنع الله إبراهيم، رواية “تلك الرائحة وقصص أخرى”. ط1، دار شهدى، القاهرة، 1986م. ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه. ↩︎
- ماهر حسن، “صنع الله إبراهيم: نعيش عصر الحرية المسجونة”. حوار: مجلة الدوحة، إصدارات وزارة الثقافية والفنون والتراث، الدوحة، العدد (14)، ذو الحجة 1429هـ ــ ديسمبر 2008م، ص: (54،53). ↩︎
- مصطفى عبد الغني، “نقد الذات في الرواية الفلسطينية”. ط1، سينا للنشر، القاهرة، 1994م، ص: (9). ↩︎
- عباس علي السوسوة، “لساني فضولي يتطفل على قراءة النص”. مجلة علامات، النادي الأدبي الثقافي بجدة، العدد (49)، مجلد (13)، رجب 1424هـ ــ سبتمبر 2003م، ص: (330). ↩︎
- من المقابلة التي أجراها معه الكاتب. في مدينة تعز، يوم الأربعاء: 16 جمادى الأولى 1429هـ ــ 21 مايو 2008م. ↩︎
- عبد الملك مرتاض، “قراءة للنقد المكتوب عن الشابي”. دورة أبو القاسم الشابي، أبحاث الندوة ووقائعها، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، الكويت، 1996م، ص: (414). ↩︎
- عباس علي السوسوة، “المدائح النبوية ـ عرض ونقد”. مجلة الثقافة، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، السنة (2)، العدد (12)، أكتوبر 1994م، ص: (110). ↩︎
- نفسه. ↩︎
- عباس علي السوسوة، “ملاحظات مفتش نظافة سويسري”. مجلة جذور، مرجع سابق، ص: (527). ↩︎
- نفسه. وانظر: أحمد بن محمد الشامي، ديوان “ألف باء اللزوميات”. ط1، دار النفائس، بيروت، 1400هـ ــ 1980م. ↩︎
- طه حسين، “الأيام”. وقد صدرت هذه السيرة في عدة طبعات، منها، طبعة مركز الأهرام للترجمة والنشر، ط1، القاهرة، 1412هـ ــ 1992م. ↩︎
- عباس علي السوسوة، “لساني فضولي يتطفل على قراءة النص”. مجلة علامات، مرجع سابق، ص: (347). ↩︎
- نفسه. ↩︎
- نفسه. ↩︎
- انظر: عباس السوسوة، “ملاحظات على كتاب البردوني (من أول قصيدة إلى آخر طلقة، دراسة في شعر الزبيري)”. ملحق صحيفة الثورة الثقافي، صنعاء، الحلقتان: الأولى، والثانية. العددان: (10523)، و(10530). 3 سبتمبر 1993م، و10 سبتمبر 1993م. ص: (8)، ص: (8). ↩︎
- نفسه، الحلقة الأولى، ص: (8). ↩︎
- ثابت محمد بداري، “عبد العزيز المقالح وتأصيل النقد الأدبي الحديث في اليمن”. مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1990م، ص: (37،36). ↩︎
- حيدر محمود غيلان، “البردوني ناقدًا”. إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 1425هـ ــ 2004م، ص: (118).. ↩︎
- انظر على سبيل المثال:
ــ عباس علي السوسوة، “في النحو التاريخي للفصحى، وملاحظات”. مجلة جذور، النادي الأدبي الثقافي بجدة، العدد (10)، المجلد (6)، رجب 1423هـ ــ سبتمبر 2002م، ص: (104).
ــ عباس علي السوسوة، “المستشرقون وخبز الشعير المذموم”. مجلة جذور، إصدارات النادي الثقافي الأدبي بجدة، العدد (12)، المجلد (7)، محرم 1424هـ ــ مارس 2003م، ص: (43).
ــ عباس علي السوسوة، “لساني فضولي يتطفل على قراءة النص”. مجلة علامات، مرجع سابق، ص: (348،336،335،334،332). ↩︎