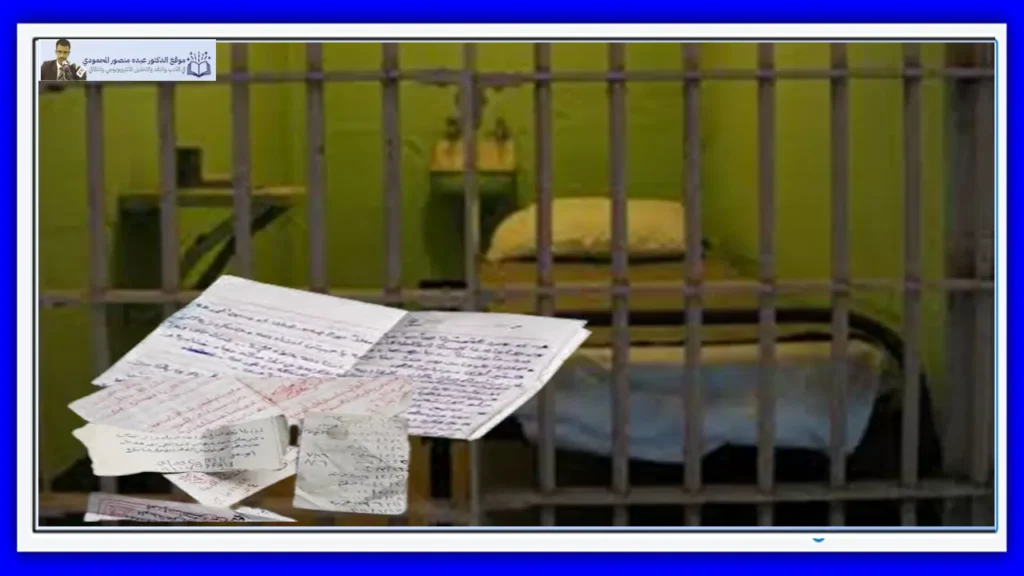المرأة وثقافة الأمكنة في الرواية اليمنية مقاربة نقدية في رواية “هذه ليست حكاية عبده سعيد”
من أنساق التحولات في حاضر اليمن وماضيه ــ التي استوعبتها السياقات السردية في رواية الكاتبة نادية الكوكباني “هذه ليست حكاية عبده سعيد”(1) ــ تسريدُ خصوصية الأمكنة وثقافاتها. بما في ذلك من محوريةٍ سردية، لعلاقة المرأة مع المكان وانتمائها إليه، وتشرُّبها لثقافته، وتمثّلها لأنساق الحياة فيه.
عدن” ملتقى التعايش والمحبة
حظيت مدينة “عدن” بنوعٍ من الاحتفاء المكثف في هذا العمل، منذ الصفحة الأولى التي استهل منها اشتغاله على سياقاته. صفحة التصدير تلك، التي تضمّنت إحالةً على واحدة من ميزات المرأة المنتمية إلى هذا المكان: “إذا رضيت عنك المرأة “العدنية” منحتْك عبقها، وإذا ما غضبت عليك دسّت في فمك ملح بحرها ومضت لحالها”(2).
لقد وُلد “عبده سعيد” ــ الشخصية الرئيسة ــ في “تعز”، وفيها عاش سنوات عمره الأولى. وفي السنة التاسعة من عمره، كان على موعدٍ مع حياةٍ جديدة في “عدن”؛ إذ حظي بفرصة عمل لدى إحدى عوائلها. وفي سياق ذلك، يشير إلى نمطٍ من أنماط الحياة في المدينة؛ إذ يقول: “جرت العادة أن تجلب العائلات الميسورة طفلًا صغيرًا يسمونه “BOY” (بمعنى ولد أو صبي) يتولى خدمتها لسهولة حركته في المنزل بين النساء، مع تمييز الفيلا التي يعمل فيها، فكنت أنا الـ”بُوي” الذي يعمل في فيلا تاجر الجملة في “حي الروزميت”(3).
هذه الحياة الجديدة ــ التي انفتحت لشخصية العمل “عبده سعيد” ــ مكّنَته من الاطلاع على بعضٍ من التفاصيل الثقافية، التي تشكّلت بها هُوّية المدينة. لا سيما ما اشتهرت به من أنساق التعايش والتسامح بين الأعراق والديانات المختلفة. من ذلك، هذه الإشارة السردية التي وردت على لسانه: “في نزهتي الشهرية مع العائلة إلى أماكن مختلفة داخل عدن وخارجها تعرفت على مساجد الطوائف الدينية من “السنة والبهرة” وعلى “معابد الهندوس” الهندية، ومعابد “النار” الفارسية، وكم أبهرتني عمارة “الكنائس المسيحية” و”المعابد اليهودية””(4).
وبعد سنواتٍ من العمل مع تلك العائلة ــ وإحراز تقدمٍ ملموس في مسار الدراسة والتعليم والعمل خارج منزل تاجر الجملة “حافظ” ــ وقع “عبده سعيد” في حب الفتاة العدنية ذات الأصول الهندوسية “منتهى”. صارح كلٌ منهما الآخر بحبه، واتفقا على الزواج. ثم سرعان ما تلألأت بهما ليلة العمر، التي تجلّت فيها صورةٌ من ثقافة أعراس المدينة. وبوجهٍ خاص ما يتعلق من ذلك بأزيائها، التي أضفت تميُّزًا ملحوظًا على “منتهى”؛ إذ “انسدل على جسدها “درعٌ” عدنيّ من الحرير الأبيض مرصّع بحبات لؤلؤ، تشي بمحار البحر وصيادين غاصوا في الأعماق لاستخراجها. ووضعت على رأسها “مقرمة” خفيفة من قماش “الجرجيت” الأبيض، تزين أطرافها زخارف ورد باللون الوردي الفاتح، وعلى لجين جبينها وضعت تاجًا أنيقًا فضيًّا، تداخلت زخارفه على شكل مثلث مقلوب قمته في منتصف جبينها وقاعدته في بداية شعرها، أما يداها وقدماها فقد طَلَتْهما بالحناء، واختارت نقوشًا رقيقة زادت من جمالها وميزت ظهورها كعروس جميلة بهية”(5).
“تعز” ثقافة العمل و”المشاقر”
بدأ تسريد المحطة الثانية من حياة “عبده سعيد” ــ التي عاشها في “تعز” بعد أن استحال بقاؤه في “عدن” لاشتراكه في حراكها الشعبي ــ بتصديرٍ، أطلت منه المرأة التعزية عالمًا من الإخلاص والوفاء والعمل: “إذا رضيت عنك المرأة “التعزية” عملت بالنيابة عنك، وجعلت منك ملكًا متوجًا على قلبها.. فإذا ما غضبت عليك، ألقت بك في وجه الريح ومضت لحال سبيلها”(6).
لم يكن في مستطاع “منتهى” الرحيل مع زوجها “عبده سعيد” إلى “تعز”. وبعد أن يئست من إمكانية عودته، قررت مغادرة “عدن”، إلى البلاد التي تحدرت منها أصولها “الهند”، ملتمسةً منه المسامحة؛ فلم يجد بُدًّا من الرضى عنها والموافقة على انفصالهما.
في الجانب الآخر، كان القدر يهيئ له تجربة حب جديدة، مع المطلقة المتفانية في العمل “بدور”، التي انجذب إليها في مناسبة عرسٍ مفعمٍ بخصائص المدينة وثقافتها. لا سيما ما يرتبط منها بفن الرقص والغناء؛ ففي ذاك العرس “كان الرقص جميلًا وتلقائيًّا ومبهجًا. يقف أهل العروسين ومن رغب من الضيوف في صفين متقابلين من النساء والرجال، يؤدون رقصات ثنائية فرحة، يتقدم فيها رجل وامرأة من كل صف بخطوات راقصة أمام العروسين قبل أن يعودا أدراجهما ويتقدم آخران، وهكذا حتى يرقص الجميع. يختم العروسان مراسيم الاحتفال برقصة تتعالى فيها الزغاريد من حولهما، وتتحول الأغنية إلى زفة يتقدمها العروسان حتى يدخلا الدار وتنتهي بدخولهما مراسيم الزفاف، فيغادر بعدها الضيوف الباحة متوجهين إلى دورهم”(7).
تداعى “عبده سعيد” مع انجذابه إلى “بدور”، فلم يفرط في أية فرصةٍ تمكّنه من رؤيتها. من ذلك، فرصةٌ منحتْه التأمل في جمالها وحيويتها، وما تزهو به من تفاصيل الثقافة الشعبية السائدة في قريتها المنتمية إلى “جبل صبر”. وبوجه خاص، ثقافة الألبسة النسائية، التي كانت نسقًا من أنساق جمال “بدور”. يقول عن ذلك: “رحت أتمعن في ملابسها، قميصها المحبوك بخيوط الحرير الخضراء والصفراء والحمراء، سروالها الأسود مُحكم القبضة على بداية ساقها، أما “عُصبة” رأسها البيضاء والمميزة لنساء “جبل صبر” بألوانها الزاهية فقد ذكرتني بـ”عُصبة” أمي ومشاقرها المفضلة زكية الرائحة”(8).
وفي الموقف نفسه، ذكّرتْ “عصبةُ” المشاقر تلك، العاشق “عبده سعيد”، بواحدة من أغاني “الملالاة” التعزِّية” المحتفية بـ”المشاقر”(9):
مشقرْ زَبَدْ فوق الخدود راوي ** عَرْفُه كوى قلبي سبعةْ مكاوي
مشقُر بياضْ جَنْبَ الجبينْ مُدَهْنِنْ ** منْ يبْصَرَكْ بلا شعور يُقَشْنِنْ
“صنعاء” ونعمة الزمان والمكان
نال “عبده سعيد” في “تعز” مراده في الزواج من “بدور”، فعاش معها المحطة الثانية من حياته، حتى أسلمت روحها إلى بارئها. وقبل ذلك ــ وبالتزامن معه ــ كانت المتغيّرات ومستجدات التطلع إلى حياةٍ أكثر رخاءً، قد ساعدت على تهيئة انتقاله إلى المحطة الثالثة والأخيرة من حياته، تلك التي قضاها في مدينة “صنعاء”.
وبالصيغة الشرطية نفسها ــ التي نُسجت بها بُنية التصدير الاستهلالي في سياقات سالفة ــ تجلّى استهلالُ تسريد بعضٍ من خصائص مدينة “صنعاء”، بتصديرٍ كشف عن الجوهر النبيل، الذي تتفرّد به شخصية المرأة المنتمية إلى ثقافة المكان: “إذا رضِيَتْ عنك “الصنعانية” وهبتْك كل ما تملك، وإذا غضبتْ منك سلمت أمرها لله ومضت لتنجو بذاكرة مثقوبة”(10).
في هذه المدينة الاستثنائية، تزوج “عبده سعيد”، من الأرملة “نعمة”، ذات المكانة الاجتماعية، ونموذج المرأة المأهولة بثقافة الإعلاء من شأن الذات النسوية، المنتصرة للتحصيل العلمي والمعرفي، غير المكترثة بكثيرٍ ممّا فُرض عليها من قيود وتقاليد اجتماعية.
وفي سياق التسريد المكتنز احتفاءً بثقافة المكان، يأتي التعريج على فرادة الزي النسائي الصنعاني. بما هو عليه من حالٍ وجدانية أثيرة، حينما تكون فيه الحبيبة.
كما هي عليه حال “نعمة”، في هذه الإشارة السردية، التي وردت على لسان (الحبيب/ الزوج): “ارتدت “نعمة” ثوبًا “صنعانيًّا” لم أره عليها من قبل من قماش “الجرز الأخضر”، ووضعت على رأسها “المَصَر النازلي” من الشيفون الأبيض و”المصر الطالعي” من قماش الثوب نفسه”(11).
وبعد سنواتٍ من الحياة الهانئة، التي عاشها الزوجان الحبيبان، توفيت “نعمة” في حادثٍ مأساوي، أسدل الستار على حياة “عبده سعيد”، الذي احتسى مرارة رحيلها، كما احتسى مرارة انكسار المشروع الحداثي المدني، فعاد إلى مسقط رأسه “تعز”. يقول: “قررت العودة لقريتي في جبل صبر، سأكون في مكان يتوسط الثلاث المدن التي عشقها قلبي، واستلذت روحي العيش فيها رغم ما عانيت. سأولي قلبي نحو الجنوب كلما اشتقت لمنتهى وسأوليه نحو الشمال كلما اشتقت لبدور، وستحتويني في صنعاء روح نعمة حتى أخلد إلى النوم الأبدي”(12).
لقد عاد “عبده سعيد” إلى حيث يتمكن ــ في مناجاته ــ من الجمع بين الثلاثية التي صاغت حياته، وأضفت عليها سعادة متجددةً، في وجه انتكاسات الحياة. تلك الثلاثية، التي تشكلت عجينتُها، من تماهي المرأة في ثقافة المكان، الذي تمثّلت خصائصه، وتفاعلت مع متغيرات الأزمنة المتعاقبة عليه.